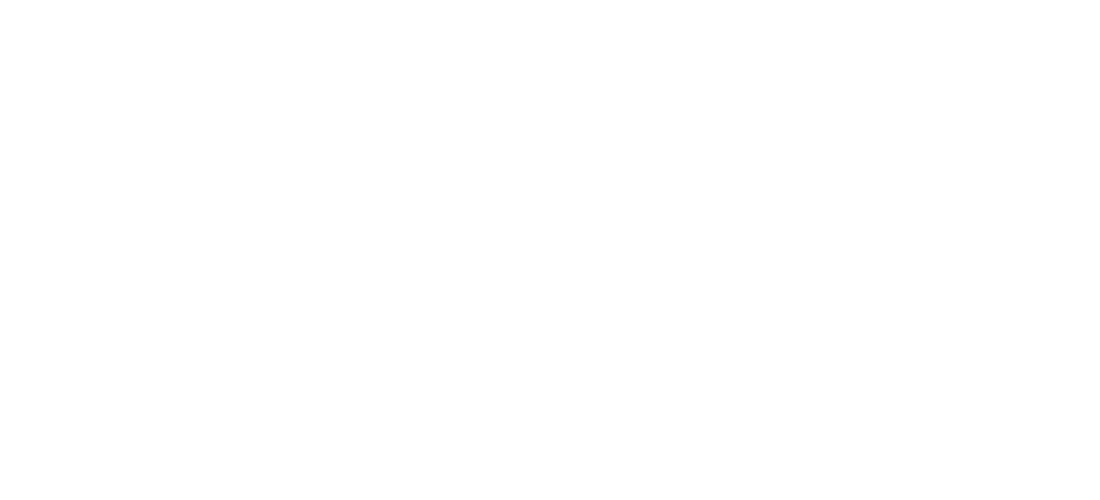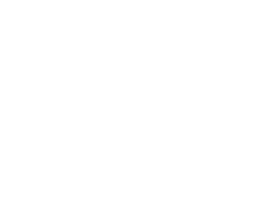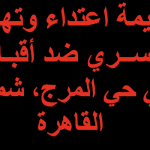د. شريف يونس (*) ـ
ظاهرة التمييز الديني في مناهج التعليم تعلن عن نفسها جهرا، لا تحوج من يريد رصدها إلى مشقة التحليل. وتوحى قراءة المناهج بأن واضعيها ممتلئين اقتناعا برسالة مقدسة فحواها تديين وأسلمة التعليم عموما، بحيث يمكن القول بأن أسلمة المناهج مجرد أحد مظاهر جهود الأسلمة المستمرة في كل جوانب التعليم وفى غير التعليم. إذا كان هذا كذلك، فما هي جدوى بحث ظاهرة بارزة لا تحتاج إلى الـ”بحث” عنها؟
لا شك أن مجرد رصد جوانب التمييز الديني في مناهج المدارس المصرية مفيد في حد ذاته لأغراض فضح الأكاذيب الصريحة بشأن ادعاءات المساواة واحترام المواطنة والحريات الدينية وما إلى ذلك، والتي لا تأتى فقط من ناحية النظام، وإنما يساهم فيها جمهرة من الإعلاميين والكُتَّاب والسياسيين غير الحكوميين. غير أن هذه الورقة لا تهدف إلى تسجيل الصوت الجهير للتمييز الديني، وإنما إلى تحليل بنيته وتحديد طبيعته وتفسيرها. يشجعني على ذلك أن مناهج التاريخ بالذات مناسبة تماما لهذا الهدف. فعلى خلاف كثير من مناهج التعليم، ليس التمييز الديني في مناهج التاريخ مجرد “تمغة” ملصقة بشكل تعسفي على مناهج لا صلة لها أصلا بأية قضية دينية، على نحو ما نجده مثلا في مناهج اللغة العربية، أو الجغرافيا، أو حتى العلوم الطبيعية. بالعكس، يمكن القول بأن فجاجة التمييز الديني تكاد تصل إلى حدها الأدنى في مناهج التاريخ، ولكن هذه المناهج تقدم، بالمقابل، صورة أوضح بكثير لمنطق التمييز وبنيته.
السبب في ذلك أن التاريخ هو المقرر الدراسي المختص أكثر من غيره ببناء هوية مشتركة معينة لمواطني الدولة، وبالتالي فإنه أكثر دقة في التعبير عن طبيعة هذا التمييز ومغزاه، باعتباره جزءا من رؤية النظام الحاكم لكيفية صياغة هوية مواطنيه. وبالتالي فإنها تكشف عن التمييز لا كمجرد خطأ أو مشكلة ملتصقة تعسفا بالمنهج، وإنما كعنصر في تصور عام للتربية الوطنية التي يعتبر التاريخ حجر الزاوية فيها، لأنه بطريقة غير مباشرة يضع الفرد داخل انتماء معين ويحدد له “إحداثيات” موقعه في مسار ما للتاريخ، وبالتالي يمنحه اتجاها ورؤية.
وجدير بالذكر أن الورقة ستركز على تحليل وضع الأقباط في البنية العامة للتاريخ كما تقدمه المناهج الدراسية، دون أن يعنى ذلك أن التمييز الديني يقتصر على التمييز ضد الأقباط. ويكفي أن نقرر مثلا أن البهائية ككل لا ذكر لها. وإذا كانت الديانة البهائية هامشية وأزمتها مستجدة، فإن التجاهل يمتد أيضا إلى الشيعة، برغم أن الدولة الفاطمية كانت شيعية، كما يمتد إلى كل الكنائس المسيحية باستثناء الكنيسة المصرية القبطية. غير أن هذه الورقة لا تدافع عن تعديل مناهج التاريخ لتحقق توازنا طائفيا أفضل، بل ربما على العكس تماما كما سنرى. فالغاية من ذكر هذه الملاحظة هو الإشارة إلى الوضع الحاصل، سواء في المناهج الدراسية، أو في المجتمع ككل، أي تمحور قضية التمييز فعليا حول قضية علاقة المسلمين بالأقباط (حسب المعنى الدارج للكلمة: المسيحيين المصريين(.
بناء على ذلك ستبدأ الورقة بتناول وضع الأقباط داخل مناهج التاريخ الحكومية في المرحلتين الإعدادية والثانوية، لتنتقل إلى فهم مغزى ذلك الوضع باستعراض الرؤية العامة للهوية المحلية كما تقدمها مناهج التاريخ، وتنتهي إلى ما تسميه الورقة جرح الهوية، من خلال رصد المشكلات الكبرى والتوترات الأساسية التي تحكم منهج التاريخ ككل، والتي تشكل الأساس الذي يقوم عليه التمييز الديني داخل المناهج، وتقترح، بناء على ذلك ما تعتبره الشروط الأساسية لتجاوز البنية المعرفية للتاريخ التي تولد التمييز الديني.
(1) الأقباط والكنيسة في التاريخ المدرسي
الطابع العام للأسلمة التمييزية في المناهج الأخرى (بخلاف مناهج التاريخ) يتمثل في إقحام يتسم بالسذاجة والعدوانية معا لنصوص وإشارات وتدريبات ذات طابع ديني في علوم لا صلة لها بشكل مباشر بأي دين من الأديان- وهو ما سنعرض لبعض نماذجه ودلالته لاحقا. ولكن مناهج التاريخ هي الأقل تعرضا لهذا الشكل من الإقحام العدواني الساذج. بل يمكن أن نعتبرها (ومعها وحدات ما يُعرف بالتربية القومية) ساحة حفظ التوازنات بين عناصر بنية الهوية التي يقدمها النظام الحاكم.
أول ما يلفت النظر في مناهج التاريخ أنها استحدثت في (ع1-2) و(ث1)([1]) تاريخا مختصرا وانتقائيا عن الحقبة المسيحية في تاريخ مصر، التي يحددها الكتابان بالفترة من القرن الثالث الميلادي وحتى الفتح الإسلامي في القرن السابع. ويتناولها بصفة خاصة من حيث نظام الرهبنة الفردية والجماعية، والمدرسة المسيحية في الإسكندرية وأثرها في الانتعاش الثقافي في الإسكندرية بفعل منافستها مع المدرسة الوثنية، كما يتناول باقتضاب الفن القبطي وعصر الاضطهاد والشهداء.
وفى إطار البنية العامة لمنهج التاريخ (وسنعرض لها لاحقا) يعتبر هذا الاستحداث لتدريس شيء عن تاريخ مصر في العصر القبطي نوعا من الترضية للأقباط. ويتفق مع هذا الميل للترضية أيضا الاعتراف بان “أهل الذمة” قد تعرضوا لـ”بعض التشددات من قبل بعض حكام المسلمين لفترة وجيزة، كما فُرضت بعض قيود على الذميين بسبب روح التعصب الديني التي سادت عالم العصور الوسطى في بلاد المسلمين وبلاد الفرنجة على السواء” (ث ع، 20). كما يشار إلى نبوغ الأطباء النصارى في العصر الإسلامي (ص 45)، وتتجنب المقررات الإشارة إلى نظام الجزية في تناول موضوع أهل الذمة. وهو ما يؤكد ما ذكرناه سابقا من أن التاريخ هو المنهج المخصص لحفظ التوازنات، لا للاستعراضات الفجة لعضلات القدرة على التمييز الديني، الذي نجده في مناهج أخرى.
ومنهج التاريخ الحديث للثانوية العامة هو بصفة عامة الأكثر بعدا عن التمييز، بل يميل إلى عرض القومية المصرية والعربية على السواء على أنهما علمانيتين بالكامل، ولكن بشكل ضمني. وكأنه يعوض نقص النزعة القومية، المصرية والعربية، في غيره من المناهج الدراسية. فعلى خلاف ما يشيعه الإسلاميون من أن القومية العربية مؤامرة صليبية غربية، يأخذ المنهج على عاتقه الدفاع عن المفكرين الشوام الأوائل واضعي فكرة القومية العربية، وهم من المسيحيين، مؤكدا أنهم رفضوا “فكرة قومية مسيحية ودعوا للاندماج مع المسلمين ضد الوجود العثماني تحت لواء العروبة” (ث ع، 162). وبالنسبة لمصر، أشاد المنهج بثورة 1919 باعتبارها “أول ثورة قومية في تاريخ مصر الحديث وبداية ظهور الأمة المصرية كأمة موحدة مكونة من مصريين فقط بدون تفرقة بين مسلمين وأقباط… [وهي] بداية ظهور مصر الحديثة التي يقوم نظامها السياسي على أساس القومية المصرية وحدها وليس على أساس الدين” (ص 186). وهو يعرض هذا التحول بشكل إيجابي، حيث أصبحت مصر بفضله “الدولة العربية الوحيدة التي لا تمزق شعبها العصبيات الدينية والقومية” (ص 188).
(2) بنية التمييز الديني في مناهج التاريخ
لا تعنى وظيفة مناهج التاريخ كساحة ترضيات أنه متوازن بالمعنى الطائفي ولا بأي معنى آخر. ليس المقصود بهذا النفي مقارنة الاهتمام الذي أولته المناهج للحقبة الإسلامية بما خصصته للتاريخ القبطي، من حيث عدد الصفحات مثلا، أو حتى اللهجة، وإنما استعراض طبيعة العلاقة بين الهويات المختلفة والتركيب الذي يجمع بينها، والذى يشكل الأساس الحقيقي الذى تأتى في إطاره الترضيات أو الاعتداءات على السواء.
وهنا يجدر أن نشير إلى أن النظام الحاكم هو الذي يضع مناهج التاريخ ويشرف على تدريسها. وبالتالي فإن هذه المناهج لا تعكس بالضرورة الرؤى الاجتماعية السائدة بشأن الهوية، بقدر ما تعكس استراتيجية نظام الحكم إزاءها. والدولة الحديثة بصفة عامة، في مصر وفى غير مصر، حريصة دائما على تدعيم هوية موحدة لسكانها بأدوات عديدة، على رأسها التعليم العام، ولكنها تشمل أيضا التجنيد والتحكم الإداري المركزي وإدماج الثقافات الفرعية (توطين البدو، “تمدين” الفلاحين، الخ). غير أن هذا لا يعنى بالضرورة أن تكون هذه الهوية الموحدة المفروضة بسيطة أو تقوم على مساواة مجردة لكل السكان. فقد تقوم الدولة الحديثة أيضا على تشجيع هويات فرعية معينة باعتبارها العامود الذي تستند عليه (مثل الدول القائمة على سيادة عِرق أو طائفة أو حتى قبيلة)، أو قد تصبح ساحة حرب بين الهويات الفرعية (لبنان). أما الحالة المصرية فيبدو أنها تقوم على المناورة بين هذه الهويات الفرعية والرضوخ لها أحيانا بدرجات مختلفة، مع الاحتفاظ بـ”سيادة” إسلامية متغيرة الشدة.
على هذا فإن الهوية المشتركة للسكان التي تروجها الدولة الحديثة ليست بالضرورة هوية وطنية بسيطة أو محايدة تجاه للهويات الفرعية، وإنما قد تكون مركبة لتعكس هوية مشتركة تنطوي على تراتب داخلي. وبالتالي يمكن، نظريا وعمليا، أن تتضمن هذه الهوية المشتركة سيادة هويات فرعية في الداخل (الرجال على النساء، جماعة دينية على أخرى، الخ)، بحيث تصبح هذه التمييزات داخلة في بنية الهوية المشتركة التي تعززها الدولة، أو حتى تكتفى بأن تصمت عنها. وفى كل الأحوال من الطبيعي أن تحتل الدولة نفسها مكانة رفيعة في التاريخ الذي تقدمه لمواطنيها.
ولكي نفهم دلالة ذلك بالنسبة لموضوعنا هنا، وهو التمييز الديني في بنية الهوية المصرية كما تقدمها مناهج التاريخ، علينا أن نتناول وضع الهويتين الفرعيتين، الإسلامية والقبطية، في علاقتها بالهوية الوطنية المؤسسة للدولة.
بصفة عامة يتمحور منهج التاريخ الرسمي المصري، على نحو ما سنرى، حول ما قد نسميه الأمة المصرية، وامتداداتها، بشكل غير مسبوق في ضيق الأفق (وسنرى ذلك ودلالاته لاحقا). ومع ذلك تكاد الآية تنعكس حين تتطرق المناهج لدراسة التاريخ الوسيط (أي العصر الإسلامي). فهنا تضع المناهج مصر داخل العصر الإسلامي. فمثلا يبدأ منهج (ع2، بفصليه الدراسيين) بالعصر النبوي، فعصر الخلفاء الراشدين، فالفتوح الإسلامية، فالدولتين الأموية والعباسية. ثم يتناول جوانب مختارة من الحضارة في العصر الإسلامي: النظام السياسي السُنى، وهو الخلافة ([2])، والحياة العلمية والفنون الإسلامية، والمعابر التي انتقلت من خلالها الحضارة الإسلامية إلى أوربا. فقط بعد هذا التاريخ الإسلامي السُنِّى العام ([3])، يخصص حوالي ربع منهج ذلك العام الدراسي (أي حوالي نصف كتاب ع2-2) لمصر الإسلامية، من الدولة الطولونية إلى المماليك.
أما منهج (ث ع) فلا يرد فيه ذكر خاص لمصر في العصر الإسلامي، وإنما يخصص القسم الإسلامي من المنهج بالكامل للحضارة الإسلامية، بدءا بأوضاع عرب الجزيرة العربية قبل الإسلام، ومرورا بنظم الحضارة والحياة الاجتماعية، والسياسية، ومواجهة المغول والصليبيين. بل يفرد المقرر فصلا لانتشار الإسلام في جزر الهند الشرقية والملايو وغرب أفريقيا جنوب الصحراء (ص 23 وما بعدها)، وهي مناطق لا يأتي ذكر لتاريخها أو حتى لوجودها في أي مقرر من مقررات التاريخ إلا فى هذه المناسبة.
ويتضح مغزى ذلك بالمقارنة مع الجزء المخصص لمصر في العصر القبطي، فسياقه العام ليس هو ظهور المسيحية وتطور الدعوة لها ومشكلاتها وصراعاتها، وإنما هو الإمبراطورية الرومانية. ليأتي تناول المسيحية كظاهرة مصرية حصرا في إطار تاريخ مصر في العصر الروماني. وفى داخل تاريخ مصر يتم التأكيد على أنها ليست نقطة تحول، بل أحد تجليات المصرية القائمة قبلها: فالشعب المصري، فيما يؤكد المنهج، يمتاز بتدينه أصلا. والمسيحية ظاهرة تعبر عن الوطنية، فقد “ربط المصري بين الدين والوطن وارتبط المصري بالكنيسة القبطية ومذهبها” (ث1، 238). كذلك ظل الفن القبطي “محتفظا بخصائص الفن المصري بعد أن ألبس الرموز المصرية القديمة لباسا مسيحيا” (ص 244). والمسيحية وفقا لمناهج المرحلة الإعدادية كانت “مفيدة” للمصريين، فقد “أقبل المصريون على اعتناق هذا الدين الجديد. هل تعرف لماذا؟ لأنهم وجدوا فيه مبادئ العدل والمساواة والرحمة والعطف والتسامح والزهد في الدنيا والتطلع إلى نعيم الآخرة… [و]وجدوا فيه خلاصا من واقعهم المضطرب [أديان مصرية قديمة ورومانية ويونانية] … [و]وجدوا فيه خلاصا من الضغوط الاقتصادية ومن القهر والإذلال الذي كانوا يعانونه تحت الحكم الروماني” (ع1-2، 91).
ولكن أهم ما في المسيحية، في المنهج الدراسي، أنها كانت في هذا العصر “سلاحا قويا في يد المقاومة المصرية للحكم الروماني وتأكيدا لعدم الخضوع لهم” (ث1، 236). وبعبارة أكثر وضوحا: “أصبح الدين أداة للتعبير عن الرغبة في التحرر من الحكم البيزنطي وظهرت لغة وطنية هي اللغة القبطية” (ث1، 238، التشديد من عندي.)
المسيحية القبطية إذن مستوعبة بالكامل في مفهوم الوطنية المصرية، بدءا من المنشأ (أي سبب اعتناق المصريين لها) ومرورا بالمسار (فنها وعلاقتها بالتدين والتقاليد المصرية القديمة)، وانتهاء بمغزاها (المقاومة التي سُميت وطنية للرومان). فهي إذن أحد تجليات هذه الوطنية التي اعتُبرت خالدة، أو حتى مجرد أداة لها حسبما يقول أحد النصوص. ولكي يزداد المغزى وضوحا نرجع مرة أخرى إلى الإسلام. هنا لا نجد أيا من هذه التبريرات، ولا يوجد دور معين للإسلام في التاريخ المصري، بل كان للمصريين دور في الدفاع عن الإسلام. فالإسلام قائم بذاته، أو أصولي، وليست له أية صفة مصرية، ولا توجد أية إشارة إلى فهم مصري خاص للإسلام، ولا هو بالأحرى أداة للوطنية المصرية، ولا يعتنقه المسلمون لمزايا معينة قائمة فيه. فهو فقط الدين الصحيح: “استند الدين الجديد إلى قانون سماوي هو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه” (ع2-1، 77).
الخلاصة إذن هي أن الحقبة المسيحية مستوعبة بالكامل في الوطنية المصرية، حتى تكاد قيمتها تقتصر على أن تكون تجليا، أو أداة، أو سلاحا، للمصرية السابقة عليها، بينما المصرية هذه نفسها مستوعبة في الإسلام، معروضة بشكل يجعلها تفتقر، على خلاف الواقع، إلى أية خصوصية.
هذا التراتب لا يعنى إلغاء للمسيحية، بل وضعها، من خلال وسيط، هو المصرية، أو الوطنية، داخل هوية إسلامية عامة. وهو ما يعنى ببساطة أن الهوية المسيحية في المناهج الرسمية هي جزء من الهوية الإسلامية. ويمكن أن نسمى هذه البنية الإيديولوجية العامة بشأن الهوية في مناهج التاريخ بنية الاحتواء المزدوج. فبدلا من مقولة “عنصري الأمة”، تطرح المناهج ما يمكن أن نسميه “ذميه حضارية“، أو فكرة الذمية في صياغة حضارية- تاريخية. فالعلاقة أشبه ما تكون بعلاقة أبوية بين الإسلام والمسيحية، وبالتالي بين معتنقيهما.
يتمثل هذا الحل السعيد بأوضح صوره في نقطة الالتقاء التاريخية بين الإسلام والمسيحية في مصر، أي الفتح الإسلامي لمصر: “كان اضطهاد الرومان ومن بعدهم البيزنطيين لكنيسة الإسكندرية حلقة أخرى من حلقات تحدى المشاعر الوطنية المصرية… حتى قدر لمصر أن تتحرر من هذا الكابوس عندما قدم العرب بقيادة عمرو بن العاص لتخليص مصر من أيدي البيزنطيين” (ث1، 240). “وتطلع الأقباط إلى الخليفة عمر بن الخطاب لكي يبعث بمن يخلصهم من مخالب الروم… وبخاصة بعد أن سمعوا أن المسلمين لا يتدخلون في عقائد الآخرين… وما أن دخل الإسلام أرض مصر حتى امتزجت دماء المسلمين والأقباط وتزوج المسلمون الوافدون من نساء القبط فامتزجت الدماء العربية بدماء الأقباط وكونت نسيجا واحد وأسرة واحدة تجمعها وحدة الأرض ووحدة الهدف والمصير” (ص 246، التشديد من عندي). فالحل السعيد، الذي يقدم بهذه الصورة منعدمة الحساسية، يتجاهل مجمل العملية المعقدة لانتشار الإسلام في مصر، بما في ذلك الثورات القبطية اللاحقة على الفتح.
***
ولكن هذه الصياغة التي تقدم العلاقة بين الإسلام والقبطية (كنوع من “ذمية حضارية”، من خلال بنية الاحتواء المزدوج التي رصدناها)، ليست سوى جانب واحد من البنية العامة للهوية في مناهج التاريخ. فإذا كان صحيحا أن القبطية مستوعبة بالكامل في المصرية، فإن المصرية هذه ليست مستوعبة بالكامل في الإسلامية. فمن جهة تحرص مناهج التاريخ على تأكيد أهمية خاصة لمصر في الإسلام، ومن جهة أخرى تهتم المناهج اهتماما كبيرا بالحضارة الفرعونية كما وكيفا، بشكل يوازى اهتمامها بالعصر الوسيط (أو الإسلامي).
هذا الوضع لا يفضي إلى مجرد إحداث نوع من التوتر أو نقص الانسجام بين المصرية والإسلامية، وإنما يصل إلى تعريض بنية الاحتواء المزدوج لنوع من الاستقطاب بين هاتين الهويتين. وتوضح قراءة التفاصيل أن هذا الاستقطاب جوهري وغير قابل للحل في إطار الرؤية التي تنبني عليها هذه المناهج. يتضح هذا بصفة خاصة في محاولة منهج (ث1) لاقتراح حل ما لهذا التوتر، حيث قرر أن التاريخ الفرعوني هو “قصة شعب التمس الحياة الكاملة في الدنيا فنجح واستقامت له الأمور إلى حد كبير، كما حاول الحصول على تلك الحياة في الآخرة فصعب عليه ذلك، فأمور الآخرة والعلم بها إنما عند الله سبحانه وتعالى علام الغيوب” (ص 254). يقوم هذا الحل، كما هو واضح، على تقديم نوع من الاعتذار عن عدم إسلام المصريين القدماء، أو عن تدريس تاريخهم برغم أنهم ليسوا مسلمين! ولكنه حل بالغ التهافت، على الأقل لأنه يأتي كتعليق أخير ضمن صفحة بعنوان “خاتمة”، أي بعد انتهاء المقرر نفسه، ولكن أيضا لأنه لا يقدم أية فكرة تبرر تدريس التاريخ الفرعوني من وجهة نظر الهوية الإسلامية.
ويمكن أن نقول نفس الأمر بالنسبة لقضية الاهتمام بمصر في العصر الإسلامي، فعلى خلاف ما يبدو للوهلة الأولى أنه لا توجد مشكلة في الإشادة بتاريخ مصر الإسلامية، فإنه في واقع الأمر يتناقض بشكل حاد مع بنية الاحتواء التي تناولناها. فمثلا يتحدث كتاب (ع2-2) بتعاطف عن الطولونيين والإخشيديين والمماليك، بل وبحياد عن الفاطميين، برغم أن الدولة الفاطمية شيعية. أي يتعاطف مع كل دولة إسلامية كانت عاصمتها في مصر، برغم أن هذه الدول جميعا، ربما عدا دولة المماليك، يمكن أن تعتبر، من وجهة نظر بنية الاحتواء المذكورة، مظهرا من مظاهر تفكك الإمبراطورية العباسية الإسلامية الكبرى وإضعافها، وبالتالي يجب أن تُدان (مثلا باعتبارها أطماع غير مسئولة، الخ). وبالمثل يحتفى منهج التاريخ الحديث بعهد محمد على (ع3-1، ث ع)، برغم أن نهضته أضعفت الدولة العثمانية وعاصمة الخلافة اسطنبول.
على هذا النحو قدمت مناهج التاريخ هوية مزدوجة بعمق، حيث تتعرض الهيمنة الإسلامية الاحتوائية لاستقطاب من جانب المصرية، بينما خلت المناهج أصلا من أية محاولة لاستيعاب الإسلامية في الهوية المصرية. والنتيجة بالطبع هي فشل عام في صياغة هوية متسقة، وانكشاف كل من الهويتين أمام تحدى الهوية الأخرى. وبرغم أن مناهج التاريخ لا تعكس، كما قلنا، مجمل المشهد العام في المجتمع، بقدر ما تعكس استراتيجية الدولة تجاه هذا المشهد، فإن هذه النتيجة معبرة إلى حد كبير عن الحالة العامة لإيديولوجية الهوية في المجتمع، بما في ذلك الاستيعاب الكامل للمسيحية في الوطنية المصرية.
(3) جرح الهوية
الجرح المتبادل للهويتين الإسلامية والمصرية في مناهج التاريخ، لا بد أن تكون له دلالات عميقة، بحكم نفاذه في صميم البنية نفسها. نحن لسنا هنا أمام “انحرافات”، أو بعض عبارات أو فصول استثنائية، وإنما أمام إشكالية تخترق المفهوم العام للهوية.
النتيجة المنطقية لهذا الجرح بالنسبة للتمييز الديني هي ما يمكن أن نسميه “تمصير” بنية الاحتواء المزدوج المذكورة. فالتمييز هنا ليس “عالميا” قائما على المفاضلة بين دينين وجماعتين دينيتين عالميتين، وإنما يتصل فحسب بالإسلام والقبطية في مصر. بعبارة أخرى فإن ما يتم احتواؤه هنا هو الجماعة القبطية، لا المسيحية كدين، ولا بطبيعة الحال مسيحيو العالم ككل. هذا يعنى أن الصراع هو صراع على الهوية المحلية، فأسلمة المناهج لا تعبر عن دولة إسلامية توسعية قائمة أو مفترضة أو مستهدف إقامتها، ولا تمثل صراحة أي تيار أو مؤسسة سياسية إسلامية التوجه، ولا هي تعرض أي تصور واقعي لهوية بديلة عن الهوية الوطنية. وبالتالي فإن “الدمية الحضارية” التي تناولناها هي شأن مصري خالص، يتعلق بتصور هوية مصر كهوية وطنية ذمية، لا بنزعة إسلامية أممية، وبالتالي فإنها مجرد إضفاء لصبغة إسلامية على الوطنية المصرية نفسها، تتمثل نتائجها المنطقية في ترسيخ أسس احتقان طائفي وتدعيمه بالمخالفة لكل ادعاءات المواطنة المتساوية.
النتيجة الأكثر أهمية لذلك هي أن التجلي الأساسي لهذه الأسلمة يقتصر بشكل ضيق الأفق على التمييز الديني في الداخل. فهذه الأسلمة لا تقدم مشروعا حضاريا أو فكريا، أو أي أفق مفتوح، ولكنه يتضمن، كنتاج جانبي، التمييز الديني. بل هو في الواقع، بسبب فقره هذا، مجرد أداة للتمييز، أو “الاستعلاء” على الأديان والمذاهب الأخرى في الداخل. بعبارة أخرى، ليس لهذه الأسلمة أي محتوى بخلاف التمييز، فهي مجرد تجلٍ لنوع من الرغبة في الشعور بالاستعلاء.
تتضح هذه الأزمة بأوضح شكل حين نتناول منهجا آخر بخلاف منهج التاريخ، هو الجغرافيا، حيث تبرز الأسلم كمجرد علامة (أو خِتم، أو تمغة) يتم إلصاقها بشكل تعسفي يخلو من أية قيمة علمية أو تربوية أو منهجية. وبالتالي تخلو هذه الأسلمة من أي مشروع أيا كان، مفصحة عن خواء خالص لا يتجاوز أفق المحافظة على التمييز الديني وتأكيده.
يبدأ منهج الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي بعبارة تحتل صفحة بأكملها، كمدخل عام للموضوع: “إننا نعيش في عالم من صنع الخالق سخره لنا وأمرنا بتعميره، فهيا بنا في جولة بين ظواهره الطبيعية وحضاراته الإنسانية لنكتشف أسراره وعجائبه التي لا تنتهي”. فالمنهج بمجمله موضوع في إطار هدف ديني، بحيث تبدو دراسة الجغرافيا والتاريخ كمجرد تنفيذ لأمر إلهي ([4]). غنى عن البيان أن علوم الجغرافيا والتاريخ لا صلة لها بأية أديان عموما، ولا هي نشأت في منطقتنا أصلا، وإنما في بلاد اليونان. واضح أيضا أن ما يسميه المنهج “عجائب” قد يكون متصلا بالتدين، ولكن “العجائب” مفهوم متناقض كلية مع العلم ([5])، فالعلم يتناول ظواهر بغرض تفسيرها، لا التعجب منها.
و”تطبيقا” لذلك، راحت معظم الدروس تؤكد أن من بين الأهداف، وأحيانا على رأسها أن “يقدر التلميذ عظمة الله [تأتى كلمة الله في الكتاب دائما ببنط أسود] في كذا: (خلق الكون، ظاهرة الليل والنهار، تنوع فصول السنة، خلق اليابس والماء، تسخير الماء في خدمة الإنسان)”. وفى (ع1-2) مطلوب من التلميذ “تقدير حكمة الله تعالى في: (تنوع المناخ على سطح الأرض، تنوع الأقاليم المناخية، عظمته في خلق النبات الطبيعي والحيوان). كما يجب أن يقدر قوته في الكوارث: (تقدير عظمة الله في حدوث الزلازل والبراكين، في حدوث بعض الكوارث وهى الفيضانات والسيول، ثم أخطار الرياح مثل الأعاصير). فالمطلوب هنا هو التشديد على ضآلة الإنسان وعجزه، بل والاحتفاء بهما، فيا له من علم وروح علمية!
وقد استُعمل هذا التوجه الديني بشكل إسلامي بالذات، سواء في الصياغة نفسها (التأكيد على العظمة والحكمة، لا الحب والرحمة) أو، بشكل أوضح، باللجوء في نسبة معتبرة من الدروس إلى الآيات القرآنية تحديدا للوفاء بهذا الهدف التربوي الديني السطحي المنصوص عليه، وعدم اللجوء ولو لمرة واحدة إلى نصوص أي دين آخر، ولو من باب ذر الرماد في العيون.
والملاحظ في كل هذه الحالات أن الأسلم مقحمة تماما، أشبه بلصق طابع التمغة كما قلنا. فالقول بأن “الله جعل الشمس مصدر الضوء والحرارة على سطح الأرض” (ع1-1، 10) وبث الآيات القرآنية في بعض الدروس لا يضيف شيئا لعلم الجغرافيا ولا يغيره ولا يجعل منه عِلما إسلاميا بصفة خاصة. وليس الحال أفضل في مجال التاريخ. فأقوال مثل أن بعض ملوك الدولة الفرعونية القديمة قد اهتموا “باستغلال كافة الموارد التي وهبها الله لمصر” (ع1-1، 74)، أو عبارة “أنعم الله على المصريين منذ فجر التاريخ بالعديد من السمات التي ميزتهم عن غيرهم، ولعل من أهمها أنه شعب يميل للتدين” (ص 105)، لا يؤسلم التاريخ الفرعوني ولا حتى يقدم تفسيرا لهذا التدين نفسه.
غير أن جرح الهوية الإسلامية أعمق من ذلك. فالهوية المحلية تخترقها تماما وتُفقدها حتى البعد العالمي المميز للإسلام كدين في حد ذاته. فحين تتناول كتب الدراسات الاجتماعية جغرافية العالم (ع3) تمتنع عن الإشارة إلى نِعم الله على الصين أو الولايات المتحدة مثلا، برغم أنها بلدان تتمتع بطبيعة غنية ومتنوعة، بما يكشف عن الهوة المتسعة بين الفكرة الدينية الكونية بطبيعتها ومحلية ومحدودية مشروع الأسلمة، فضلا عن فقره، وكأن الله إله محلى يتولى رعاية المسلمين وحدهم، أو المصريين المسلمين، أو العرب المسلمين، أو مصر. ولكي نتعرف على مدى عمق الجرح يكفي أن نتخيل أن المنهج “صحح” نفسه وقال أن الله قد حبا الولايات المتحدة أو الصين بطبيعة فائقة التنوع والغنى مثلا.. سيبدو هذا في السياق الهوياتى ضيق الأفق الذي يكتنف المناهج أقرب إلى الكفر أو السخرية.
أكثر من ذلك، تكاد عملية التديين (وفى قلبها الأسلمة) تفقد القدرة على الوعي بنفسها وأهدافها، لتكشف صراحة عن سطحيتها وتعسفها، بالإلحاح واختلاق المناسبات للزج بكلمة هنا أو هناك. مثلا يطلب الكتاب المقرر (ع2-1، 49) من الطالب بعد درس الحبوب الغذائية في الوطن العربي أن يترك الجغرافيا ويلجأ لكتب الدين ومعلميه قائلا “تحدثت الكتب السماوية عن القمح، أكتب ما يدل على ذلك وعلق عليه في سطرين. استعن بمعلم التربية الدينية”، وهو ما لا يضيف شيئا بطبيعة الحال للموضوع. ومن الأمثلة المضحكة (وشر البلية ما يضحك) التدريبات بشأن خطوط الطول والعرض (ع1-1، 22) حيث يُسأل الطالب أن يحدد الفارق في موعد أذان الفجر، بالذات، بين مكة وتونس بعد إعطائه خطوط الطول للمدينتين. مثل هذا السؤال لا صلة له بقضية الطول والعرض، ولا حتى بحساب فارق التوقيت بين مكة وتونس، بقدر ما يتصل بإثبات هيمنة إسلامية على المناهج، بلا فكرة ولا قيمة معرفية.
ومن الطبيعي لمشروع خاوٍ وفقير إلى هذه الدرجة أن يخلع برقع الحياء نهائيا ليكشف مباشرة عن اهتمامه الرئيسي، أي “الكيد” للأقليات الدينية، سواء بملء الكتب على اختلافها بالآيات القرآنية، أو مطالبة المسيحيين بحفظ الآيات (غير المناسبة للتلاميذ عموما لتعقيدها اللغوي). ولعل من الأمثلة الفادحة في انعدام الحس الوطني والتربوي على السواء أن تتضمن التدريبات التالية مباشرة للدرس المخصص لتاريخ العصر القبطي هذا السؤال: “أكتب عشرة أسطر إلى الرسام الدانماركي الذي أساء إلى رسول الله… مبينا له أن الحرية لا تعنى الإساءة إلى دين الآخرين” (ع1- 2، 98). وكأن واضعو المنهج استشعروا ألما من اضطرارهم لإفساح بضع صفحات للتاريخ القبطي، مما تطلب تعويضا. هذه الأمثلة تعبر عن هوية دفاعية في جوهرها تعاني من خواء قاتل، وتتلهى عن مأساة فقرها المزرى باستخدام أية سلطة متاحة لتأكيد “سيادة الذات” الفقيرة هذه، أي سيادة فقرها بالذات. أما الفقر والجهل التربويين فتبرزهما حقيقة بسيطة، أن هذا السؤال موجه لطفل عمره أحد عشر عاما لا يُحتمل أن يكون قد سمع أي شيء عن الرسام المذكور، ناهيك عن كتابة عشرة أسطر كاملة.
يمكن اختصار جرح الهوية من هذا الجانب في أن الإسلامية أقحمت نفسها كهدف تربوي، بغير أن يكون لديها أي مشروع أصلا سوى تأكيد هذه “السيادة” الخاوية من أي مضمون، وبالتالي أبرزت عمليا أزمتها وفقرها الشديدين.
———–
* أستاذ التاريخ بجامعة حلوان
البحث كتب في فبراير ومارس 2009، لمؤتمر في أبريل نفس السنة عن التمييز الديني في** مناهج الدراسة عموما. ونُشر في كتاب “التعليم والمواطنة” الصادر عن المجموعة المنظمة للمؤتمر. نعيد نشره هنا لأن موضوعه الأساسي هو بنية هوية الدولة، من قبل حتى مجيء الإخوان السلطة، ومشاكلها الجوهرية. وأدخلت تعديلات صغيرة جدا عن المنشور
([1]) رجعنا في هذه الورقة إلى الكتب الآتية، كتب الوزارة لمادة “الدراسات الاجتماعية” لعام 2008- 2009، للصفوف الإعدادية، بواقع كتابين لكل صف دراسي (للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني)، عدا الصف الثاني الإعدادي، حيث توفرت لي طبعة 2007- 2008. ويشار إلى كتب المرحلة الإعدادية في المتن بالرمز “ع”، أما للمرحلة الثانوية، فهناك كتابان: “مصر وحضارات العالم القديم” للصف الأول الثانوي، ويشار له برمز (ث1)، وكتاب “الحضارة الإسلامية وتاريخ العرب الحديث” للثانوية العامة، ويشار له برمز (ث ع). ومن باب التيسير يشار إلى مصادر النصوص من هذه الكتب كالآتي: رمز السنة الدراسية، يتلوه رقم الصف ثم رقم الفصل الدراسي، ثم رقم الصفحة بعد الفصلة. مثلا: (ع1-2، 32) يساوى: كتاب الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني، صفحة 32.
([2]) لا نجد تعريفا للمذهب الشيعي في دروس ظهور الإسلام (ع2-1)، سوى أن ثوراتهم من أسباب سقوط الدولة الأموية (105)، وإشارة إلى ظهور دول شيعية مستقلة (108). ثم يأتي تعريف بمناسبة الدولة الفاطمية في (ع2-2). بخلاف ذلك لا يوجد للشيعة أو مذهبهم أي ذكر.
([3]) ومع ذلك يُغفل هذا التاريخ مثلا الصوفية، على أهميتها الشديدة لمعظم السكان المسلمين في جانب كبير من العصر الإسلامي.
([4]) أيضا، يبدأ الدرس الأول عن “ظواهر كونية” بالآتي: “عزيزي التلميذ: لقد خلق الله (التشديد في الأصل) هذا الكون وأمرنا بالتدبر فيه لنتعرف على مظاهر قدرته” (ع1-1، 2).
([5]) بل وليست متصلة بالدين أيضا بشكل وثيق. مثلا لم يكن النبي إبراهيم، والذي تعترف به الأديان الثلاثة، في حاجة إلى العلم لكى يؤمن بالله من خلال التأمل في الطبيعة.