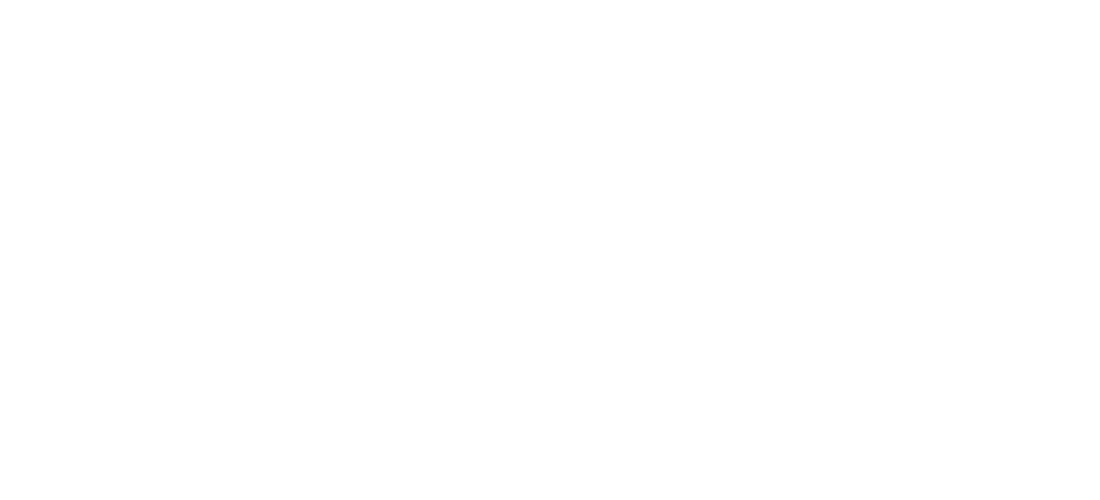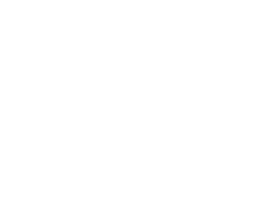حامد عبد الصمد ـ مجلة ميريت الثقافية ـ
قبل أن نجيب على سؤال إذا ما كان التنوير المصري قد فشل أم لا يجب علينا أولاً أن نذكر تعريف التنوير ومعايير نجاحه وفشله. التنوير في نشأته وتطوره هو تجربة أوروبية خالصة نقلتها بعض البلدان والثقافات ورفضتها أو تجاهلتها ثقافات أخرى، إما بسبب بُعد هذه الثقافات عن دائرة التأثير الأوروبية أو بسبب شدة قربها من وشدة عدائها التاريخي لأوروبا.
لم يكن التنوير وليد عصر الأنوار في العصر الثامن عشر فقط، بل له تاريخ طويل يبدأ بالأسطورة اليونانية التي كان بها من البراح والخيال ما سمح بمولد الفلسفة وتعظيم دور العقل، ثم جاء الإنسانيون الأوائل من الفلاسفة السفسطائيين، ثم جاءت الغنوصية التي حاولت مصالحة المسيحية مع الفلسفة، ثم مر التنوير بأزمة أثناء القرون الوسطى في أوروبا حين سيطر الفكر الديني على الحكام والعوام وتم شيطنة الفلسفة، ثم استرجع بعض قواه في عصر النهضة مع ظهور تيارات جديدة في الفن والأدب أعادت بناء الجسر بين أوروبا والثقافة الإغريقية القديمة وفلسفتها، وكان للعرب دور هام في إعادة بناء هذا الجسر، ثم ظهرت الحركة الإنسانية الجديدة وتلتها حركة الإصلاح الديني ونقد الكنيسة الكاثوليكية، ثم جاءت الثورة الفلسفية الجديدة التي لم تكتف بطرح أسئلة مجردة عن الخير والحق والجمال، ولا حتى بمسألة وجود الله، بل تطرقت إلى قضايا الدولة والعقد الاجتماعي بين المواطن والدولة وقضايا التعليم والقانون.
الفن والأدب والفلسفة غيروا علاقة الشعوب بالنصوص الدينية وطريقة قراءتها وتأويلها. العلم غيّر نظرة الإنسان للكون، فلم تعد الأرض بعد كوبرنيكوس وجاليليو هي مركز الكون كما كان يظن الناس قديماً، ونظرية التطور لداروين غيرت نظرة الإنسان لنفسه ولقصة الخلق ولعلاقته بالكائنات الأخرى. ونظريات فرويد في علم النفس غيرت نظرة الإنسان لتصرفاته ومشاعره وعقله الباطن. الثورة الصناعية خلقت ديناميكية اقتصادية ومجتمعية جديدة وخلقت طبقات أخرى غير طبقة الارستقراطيين والفلاحين، والثورة الجنسية غيرت العلاقة بين الجنسين وحررتهما من أدوارهما التقليدية.
ديكارت وسبينوزا هم أبناء أرسطو، وتوماس هوبز وجون لوك وروسو هم أبناء أفلاطون. وفولتير وجون ستيوارت ميل ونيتشه هم أبناء أسطورة بروميتثيوس الذي سرق النار من الآلهة ليعطيها للبشر. مايكل أنجلو وليوناردو دافنشي هم أبناء الفن الهيلينيستي، وآينشتاين هو ابن نيوتين، ونيوتين هو ابن أرخميدس وأبيقور. وأفلام هوليود ومسلسلات نيتفلييكس هم أبناء شيكسبير وجوته، وشيكسبير وجوته هم ابناء سينيكا وهوميروس. كل هؤلاء أبناء منظومة تنويرية لها عدة روافد مثل مجموعة جداول تلتقي في مكان وزمن ما فتصير نهراً كبيراً يجرف معه كل شيء في طريقه. كان الجديد من هؤلاء يستفيد من القديم ثم ينتقده كي يطوره ثم يتخطاه إلى فضاءات وتجارب جديدة. هكذا يتطور الفن والعلم والفلسفة، وهكذا تتطور المجتمعات.
إذاً فالتنوير ليس مجرد ثمرة يمكن لأي أحد أن يقطفها ويأكلها، ولكنه شجرة كبيرة لها جذور ضاربة في أعماق الأرض وغصون لا تتوقف عن النمو ولا تتوقف عن طرح ثمار جديدة. هو تراكم معرفي ومجتمعي عبر قرون طويلة. هو أسلوب حياة ونظرة متكاملة للإنسان والمجتمع والدولة قائمة على العقل ونظرية المعرفة. التنوير ينظر إلى حرية الفرد وتطوره وأمنه وتعايشه السلمي مع الآخرين كأول أولويات التعليم والتشريع. أما الدين فليس قضية من قضايا التنوير إذا ظل مجرد رافد روحاني وأخلاقي للمجتمع. وقد حاول فلاسفة التنوير الأوائل تجاهل الدين أو تجنبه، ولكن بدأت مشكلتهم مع الدين حين رفضت المؤسسات الدينية العلم لأسباب دينية وحين أعلت من شأن النص المقدس وتشريعاته على حساب الإنسان وحريته ومصالحه. والصراع بين التنوير والدين كان ولا يزال صراع بين الحرية والغصب، وبين الأسطورة والعقل.
ولب مشكلتنا كسكان الشرق الأوسط مع التنوير هو علاقتنا بالزمن والتاريخ والأسطورة والمقدس والفن والأدب والعلم والفلسفة، وعلاقتنا بالفرد والمرأة والآخر، وعلاقتنا بالجسد وبالحرية. علاقتنا بالزمن مضطربة لأننا نرى لحظة البعثة المحمدية كتتميم للتاريخ، فكل ما قبلها جاهلية وظلام وكل ما بعدها غير ذي قيمة، فخير القرون هو قرن الرسول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. وكلما ابتعدنا عن زمن النبوة قلت قيمتنا، ولا كرامة ولا ازدهار إلى في إعادة استنساخ تجربة دولة المدينة المنورة واتباع تعاليم القرآن والرسول، لأننا قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.
وهذه النظرة تجعل علاقتنا بالعلم مضطربة، فحين نبحث عن العزة في الدين فقط يفوتنا قطار العلم، وحين نضطر للتعامل معه نحاول إخضاعه للدين عن طريق أكذوبة الإعجاز العلمي. الدين جعلنا نقسم التاريخ لجاهلية ونور ونقسم العالم لمؤمن وكافر، ونحن بهذا نقطع الطريق بيننا وبين الثقافات التي سبقتنا والتي جاءت بعدنا ونحرم أنفسنا من تجاربهم ومعارفهم. الأصولية الدينية جعلتنا نستنجد بالماضي لنحل مشاكل الحاضر فازدادت هذه المشاكل تعقيداً. جعلتنا نفصل النص المقدس عن سياقه التاريخي والسوسيولوجي وعن الفلسفة والأدب والتحليل اللغوي، فجعلنا الدين معياراً لكل شيء. حتى حين نتحدث عن التنوير نجعل الدين مقياساً له فنظن أن التنوير هو مجرد تطوير الخطاب الديني. جعلتنا ننظر للفرد والمرأة والجسد من منظور أخلاق القبيلة لا من منظور المجتمع المفتوح، وهكذا أهدرنا طاقات النساء والرجال في محاولة التوفيق بين متطلباتهم النفسية والجسدية وبين توقعات الدين والمجتمع (القبيلة) منهم. أما ما تبقى من هذه الطاقة فيضيع في النفاق لأنهم في الغالب لا يستطيعون خلق هذا التوازن بين احتياجاتهم وتوقعات المجتمع. جعلتنا الأصولية الدينية نقرأ التاريخ كأنه خط مستقيم فيه الغرب شرير على طول الخط ونحن طيبون ومظلومون على طول الخط، فلا نستفيد من منتوجه الفكري والعلمي ونهدر الطاقات في كراهية تسممنا ولا تضر من نظنهم أعداءنا. وهكذا كانت التجارب التنويرية عندنا تجارب فردية كجداول صغيرة لم تلتق أبداً لتكون تياراً قوياً، فجفَّ معظمها وسط صحراء الرجعية الدينية وصخور الاستبداد السياسي.
وهنا يأتي السؤال: هل التنوير تجربة مناقضة لطبيعتنا وتجربتنا وتاريخنا ومناخنا كعرب أو كشرقأوسطيين؟ هل ظهور الديانات السماوية في منطقتنا على وجه التحديد حال بيننا وبين تجارب فكرية ومجتمعية مغايرة؟ ولكن كيف تحررت المسيحية واليهودية في الغرب من التراث القبلي الإبراهيمي؟ الإجابة هي: الفلسفة. الفلسفة هي أم العلوم وأم نظرية المعرفة. الفلسفة هي التي روضت الأسطورة الدينية ووضعتها تحت مظلة العقل. ولعل تجربة الإصلاح اليهودي في أوروبا (الهاسكلا) هي أقرب لواقعنا اليوم من تجربة التنوير الأوروبية، وكان أحد رواد هذه الحركة هو فيلسوف ورجل دين في نفس الوقت وهو موسي مندلسون في القرن الثامن عشر. كان اليهود في عصره يعيشون في أحياء مغلقة معزولة عن المجتمع الألماني وكانوا يرتدون القفطان والملابس التقليدية فكانوا يبدون كجسد غريب داخل المجتمع الألماني وكانوا يصرون على تطبيق شريعتهم اليهودية في كل الظروف، لكن مندلسون ذكرهم بمبدأ تعطيل الشريعة القديم من زمن الأسر البابلي والذي ابتكره حاخامات اليهود للتعايش مع ثقافة غريبة عليهم ألا وهو مبدأ “دينا دي ملكوتا دينا”، أو القانون هو قانون الملك. ثم طالبهم بنزع ثيابهم الغريبة عن المجتمع الألماني وارتداء الملابس الحديثة، وراح يهتم بتدريس بالعلوم والفلسفة داخل معابد الطائفة اليهودية، وشجعهم على ترك الأحياء اليهودية والعمل بمهن مثل الطب والمحاماة والتدريس. وقال مقولته الشهيرة: كن يهودياً في بيتك وألمانياً في الشارع! وهكذا خرج من بين يهود أوروبا في ظرف قرنين من الزمان عباقرة في الطب والفيزياء والفن وعلم النفس وشاركوا في تجربة التنوير الأوروبية بقوة. خرج منهم عشرات الحاصلين على جائزة نوبل في كل مجالات العلوم والآداب، كما خرج منهم سيجموند فرويد الذي أزال القدسية عن القصص اليهودية وعن شخصية موسى عن طريق التحليل النفسي، واستخدم معهم نفس أسلوبه في تحليل الأسطورة الإغريقية. واليوم يفتخر اليهود بعباقرتهم حتى الذين أنكروا تاريخية القصص اليهودية وحتى من أنكروا وجود إله من الأساس.
ولكن القصص الدينية في ثقافتنا الإسلامية والمسيحية الشرقية، رغم أنها مبنية أيضاً على أساطير، قد خاصمت الحضارات والفلسفات القديمة التي استقت منها قصصها وأساطيرها في مصر والعراق وشيطنتها إلى حد ما ولم تبرز دورها الفكري والحضاري بالشكل الذي يليق بها. تحولت عندنا الأسطورة إلى تاريخ، وتحولت الفلسفة إلى تهافت وضلال، ورحنا نلعن علماءنا وفلاسفتنا بدلاً من أن ندين لهم بالعرفان، ورحنا حتى نسجن من ينادون بتنقية التراث وتجديد الخطاب الديني دفاعاً عن القرآن والرسول، فظلت ثقافتنا محبوسة في العاطفية والقبلية الساميّة وفي العقلية السحرية التي تعيش في الماضي وتنتظر الخلاص في المعجزات أو في القائد الملهم المخلص، في حين تحرر العقل الغربي من الخرافة والعاطفية واعتمد على الابستمولوجيا والمنطق والتجربة فأنتج عقلية الصانع المحلل المنتج، وهذا الفرق يذكرني بتقسيم الفيلسوف الإنجليزي فرنسيس بيكون للبشر والمفكرين، حين شبّه بعضهم بالنمل الذي يجمع أشياءً ويحتفظ بها دون أن ينتج شيئاً جديداً، وشبّه بعضهم بالعنكبوت الذي ينسج حول رأسه خيوطاً تصير سجناً له، وشبّه بعضهم بالنحل الذي يتغذى على رحيق الأزهار لينتج عسلاً.. ربما مازالت العقلية الدينية القبلية في مجتمعاتنا محصورة في دور النمل، فهي تعيش على ما جمعته من أفكار ونصوص قديمة ولا تنتج ما يفيدها في عصرنا هذا. عقلية النملة تعيد انتاج نفس النموذج الفكري والسياسي بصيغتين مختلفتين في الشكل لا في المضمون: إما الأصولية الإسلامية مثل حكم البشير وطالبان وإيران وحماس وداعش أو الـ ستالينية البدوية مثل حكم عبد الناصر والقذافي وصدام والأسد وبوتفليقة وآخرون.
وربما لا تزال العقلية التنويرية عندنا أيضاً محصورة في دور العنكبوت أو النملة، فتنتج أو تعيد انتاج نفس الأفكار القديمة وتحاول إعادة صياغتها بشكل أفضل دون تغيير المضمون، وتظل محبوسة في شباك ما أنتجته دون أن يكون المنتج النهائي مفيداً لها أو للمجتمع بشكل عملي. عقلية تنقصها الجرأة والإبداع ويغلب عليها العاطفة الدينية، فتتجاهل أفكار سلامة موسى وفرح أنطون وأحمد لطفي السيد، وتركز على أفكار محمد عبده وعبد المتعال الصعيدي لإضفاء شرعية دينية على فكرة التنوير. ومع ذلك لا أريد أن أقول إن تجربة التنوير عندنا فشلت كلياً، ولكنها مازالت تحبو وما زالت تخطو خطوة وتتراجع خطوة، ما زالت تنقصها شجاعة جوردانو برونو وشك ديكارت ومنهجية إيمانويل كانط وسخرية فولتير ووضوح رؤية جون ستيوارت ميل. ومشكلتها هي أن عليها أن تعيش كل مراحل التنوير في عصر واحد وبسرعة شديدة في حين أن مزاج الحكام والعوام والظروف السياسية والاقتصادية والإقليمية لا يزالوا ضدها.
لا أستطيع أن أقول ان تجربة التنوير عندنا فشلت بشكل كامل وأنا أعلم أن عشرات الآلاف عندنا أصبحوا يقرأون لطه حسين وأحمد لطفي السيد وسلامة موسى وفرج فودة وسيد القمني وريتشارد دوكنز وتولستوي ونجيب محفوظ وأورهان باموك، والملايين ويشاهدون فيديوهات تنويرية ليس فقط بما يتعلق بنقد الأديان، فالدحيح تنويري، وبرامج تبسيط الفلسفة تنويرية، والكثير من مسلسلات نيتفليكس تنويرية وفيروز تنويرية لأن كل هؤلاء يحثون على التفكير، أو يرسخون للفردية والحرية، أو يبرزون الجمال أو يناقشون قضايا المجتمع وآلام البشر.
التنوير ليس نادي سري يلتقي فيه الفلاسفة ويتحدثون بلغة معقدة لا يفهمها أحد سواهم، بل هو أسلوب تفكير وأسلوب حياة.. حياة ترفض الوصاية وتحترم العقل. كل ما يحتاجه التنوير هو نساء ورجال بعقلية النحلة التي تمتص تجارب ومعارف الآخرين لتنتج معارفها وتجاربها هي، لا النملة التي تختنق تحت تراث جمعته ونمقته. ولا العنكبوت الذي يدور حول نفسه في بيت صار سجناً.
بالنهاية، أظن أن التغيير ليس مجرد خيار بل هو حتمية تاريخية في ظل تطور الوعي البشري. وهناك طريقان للتغيير: طريق الكوارث والحروب الدينية والأهلية وتفكك الدول والمجتمعات، أو طريق التصالح مع العالم ومع المعرفة والحرية وشجاعة الشك والبحث والتجديد. أوروبا اخذت الطريق الثاني بعد أن أدماها الخيار الأول، فماذا نحن فاعلون؟