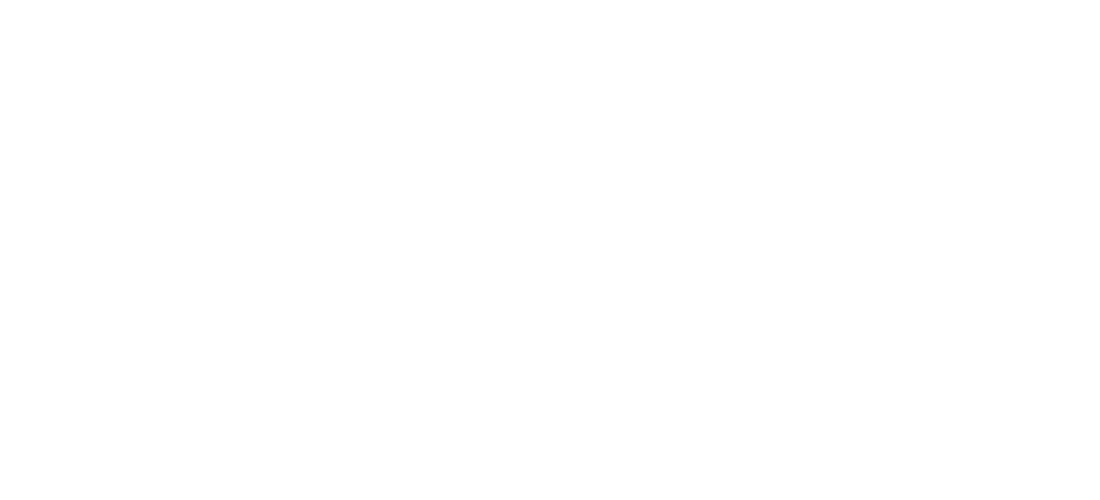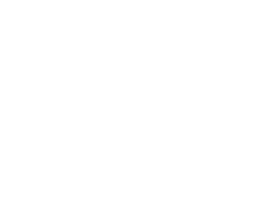أميرة المصري ـ التضامن القبطي ـ
استيقظ الطفل «ميخائيل»، الذي لم يكمل عامه الثامن بعد، ذات يوم ليجد نفسه حائرا بين الديانة المسيحية والإسلامية. بالطبع لا يملك الطفل خيارا أو قرارا، فكل ما كان يعرفه هو بيت آمن، وأسرة ترعاه، لكنه وجد نفسه فجأة انتزع من أسرته، ونُقل لإحدى دور الرعاية.
تعود التفاصيل لعام 2016، حينما عثر على طفل رضيع أمام مكتب القمص مرقس جرجس، لكنيسة «الشهيد العظيم مار جرجس» بأبي زعبل، ملفوفا بلفافة عليها صورة العذراء مريم، وفقا لما رواه عدد من الشهود، ووفقا أيضا لما ذكرته الأسرة في دعواها ـ التي اطلعت منظمة التضامن القبطي عليها ـ والتي فيها اختصمت أسرته كلا من وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي.
الطفل كان في حالة سيئة، وهو ما دفع رجال الكنيسة الذين عثروا عليه لاستدعاء الدكتور رمسيس نجيب بولس، لكونه مدير مستوصف مار جرجس المجاور للكنيسة، للكشف عليه. وبالفعل تم إجراء الإسعافات الأولية له، وحينها أبدى الطبيب رغبته في تبني الطفل ورعاية، لكونه لم يرزق بأطفال.
تقول الأسرة في الدعوى، أن بعد ما يقرب من عام ونصف، تم انتزاع الطفل منهم، بزعم أنه «مسلم» ويجب إيداعه بدار رعاية، وهو ما دفعهم لإقامة الدعوى رقم 12864 لسنة 78 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري. وحتى كتابة تلك السطور لم تنته المعاناة، إذ أن المحكمة قضت (بتاريخ ٢٣ يناير) بعدم اختصاصها في نظر الدعوى، ولا يزال الطفل ـ الذي تم تغيير اسمه من ميخائيل لـ «كريم» ـ مودعا بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما أنه أسرته لا تتمكن من رؤيته أو الاطمئنان عليه. وتنتظر الأسرة التحرك القانوني المقبل، إما الطعن على عدم الاختصاص أو التقدم بالدعوى أمام درجة أعلى، بالمحكمة الإدارية العليا.

ميخائيل وشنوده
تلك الواقعة، تعيد إلى الأذهان واقعة الطفل شنودة، المماثلة لها، والذي تم انتزاعه من الأسرة أيضا، وبعد وقت طويل بالمحاكم، وحملات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، قررت النيابة العامة إعادته لأسرته بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية، الذي أصدر فتواه، بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته.
قصة شنودة التي بدأت في 2018، بدايتها كانت مماثلة لقصة ميخائيل، فالأول عثر عليه، وفقا لتصريحات الأسرة حينها، أمام الكنيسة، وقال الزوجان في عدة لقاءات تليفزيونية وصحفية، إن وجود الطفل عند باب كنيسة يجزم بديانة أهله الحقيقيين، لكنه تم انتزاعه منهم بعد ما يقرب من 4 سنوات قضاها كطفل طبيعي يعيش وسط أسره ترعاه، وتوفر له الحماية أيضا.
هاتان الواقعتان، تطرحان العديد من الأسئلة، على رأسها: لماذا تهتم الدولة بالديانة، أو بشكل أدق تهتم بأن يصبح كل الأطفال مجهولي النسب تابعين للديانة الإسلامية، بغض النظر عن ظروف العثور عليهم ومع إغفال تأثير تبعات انتزاع طفل تعوّد على شكل حياة مستقر وفرته له إحدى الأسر البديلة، ليصبح واحدا من الأطفال بإحدى دور الرعاية، يفقد غرفته، وسريره وألعابه ووالديه الذي أصبح لا يعرف سواهم؟ لماذا لا تولي الدولة الاهتمام الأول لمصلحة الطفل، بغض النظر عن الديانة التي يتبعها، والتي لا يعرف في مثل هذا السن الفرق بينها وبين الديانة الأخرى، ولا يملك قرار الاختيار؟
دين الفطرة
ولد «على دين الفطرة»، ربما تلخص تلك العبارة الإجابة التي تسير الدولة على نهجها، إذ تفترض أن جميع الأطفال مجهولي النسب لا بد وأن يتبعوا «الفطرة»، وهي من ــ وجهة نظر الدولة ـ الديانة الإسلامية. لكن من وضع تلك الإجابة، ولماذا يجب اعتبارها الإجابة الصحيحة التي لا يمكن الابتعاد عنها، وما هو التهديد إذا اعتبرت الدولة أن هناك تهديد يمكن حدوثه من تبني أسرة مسيحية لطفل مجهول النسب، ومنحة حياة كريمة.
لمحاولة الإجابة بشكل أكثر وضوحا، يمكننا عكس الوضع: ماذا لو كان «ميخائيل» قد وجدته أسرة مسلمة أمام باب كنيسة، وقررت تبنيه ورعايته، هل كانت ستتحرك الدولة لانتزاعه على اعتبار أنه وجد على باب كنيسة، فإذن يمكن استنتاج أن أسرته البيولوجية تنتمي إلى الديانة المسيحية، وبالتالي يتبع الطفل نفس الديانة المسيحية أيضا؟ بالطبع لا، لأن الدولة ـ كما ذكرنا أعلاه ـ ترى أن الجميع ولدوا على «دين الفطرة»، بل كانت ستشجع الأمر، لأن الطفل مهما كانت قوة احتمالات انتمائه للديانة المسيحية، لكنه عاد ـ من وجه نظر أجهزة الأمن ـ للأسرة التي تتبع الدين الصحيح.
كيف يمكن أن تكون «القسوة»، هي القرار السليم الذي تتبناه الدولة وتسير على نهجه؟ حدث الأمر مع شنودة ويحدث حاليا مع ميخائيل، فانتزاع طفل من أسرته قسوة، وانتزاعه من ملابسه التي أحبها واختارها مع أبويه، ومن طعامه الذي تعده له أمه، ومن بين لعبته التي يحتضنها قبل النوم، وربما قصه ترويها الأسرة، هو قسوة لا مثيل لها، ولا مبرر لها، فأين المصلحة الفضلى للطفل التي يجب أن تكون أساس التعامل في القضايا المتعلقة بالأطفال؟
المكاسب والمخاطر
بعيدا عن المشاعر القاسية التي يعيشها الطفل والأسرة، فإذا نظرنا للمكاسب والمخاطر، ما الذي يمكن أن تحققه الدولة من مكاسب في تلك الحالة؟ لا شيء سوى المخاطر. فتغير الحياة المفاجئ بالطبع سيؤثر على نفسية الطفل، وربما يدفعه لمحاولات هروب في المستقبل من الدار، لأنه بالطبع لا يتلقى الطفل فيها نفس المعاملة التي يتلقاها بالأسرة، حتى لو كانت أسرة بديلة.
في الدعوى السابقة التي أقامتها أسرة شنودة، وفي الحالية التي تمضي بها أسرة ميخائيل، أكدت كل من الأسرتين أن الطفل وجد أمام الكنيسة، وهو ما يزيد الاحتمالات حول أن الأم البيولوجية مسيحية، وبالرغم من تأكيد الأمر من خلال الشهود في كلا الدعوتين، إلا أن المحكمة لم ترى أن ذلك أمر كاف أو دليل يمكن الأخذ به، فالدليل الأقوى بالنسبة لها والذي تسعى لإثباته هو أن الطفل مسلم برغم وجوده أمام كنيسة، ووجوده أيضا داخل لفافة عليها صورة السيدة العذراء.
تتبع الدولة القوانين ذات المرجعية الدينية، والتي تساعد على التمييز بين المواطنين وليس المصلحة، كما تؤكد الدولة دوما. فالقانون المصري نظريا يكفل حرية الاعتقاد ويسمح لمن تخطي الـ18 عاما تغيير ديانته، لكن عمليا وفعليا لا يتم الأمر ومن المستحيل لشخص مسلم التحول للديانة المسيحية. بينما في المقابل نجد سهولة الأمر والترحيب به في الحالة العكسية.
القوانين السارية حاليا
حظرت الدولة المصرية التبني بمفهومه الأوسع عندما أصدرت قانون الطفل رقم 12 في عام 1996، وأجرت عليه عدة تعديلات كان آخرها تعديل في لائحته التنفيذية في عام 2010، واعتمدت بدلا من ذلك «نظام الأسر البديلة» الذي ينص على «إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولي النسب، بأسر يتم اختيارها وفقاً لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية». وهو ما يدفع المؤسسات لرفض إصدار الموافقات على طلبات التبني للمسيحيين، بحجة أنه يتعارض مع النظام العام.
وبالرغم من أن قانون الأحوال الشخصية لا يضم مادة واضحة النص تحدد ديانة مجهول النسب، وكيفية إدراج ديانته بشهادة ميلاده، ولكن المعتاد أن الحكومة، ممثلة في هيئة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، تختار له اسما ثلاثيا وتنسبه إلى الدين الإسلامي، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، التي تنص على أن الطفل المولود في دولة مسلمة وغير معلوم الأب والأم يصبح مسلما بالضرورة.
بالعودة لـ «ميخائيل»، فما يحدث الآن معه بالشق القضائي حدث من قبل مع شنودة: محكمة القضاء الإداري قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأسست المحكمة حكمها، على أن قرار إيداع الطفل دار رعاية اجتماعية لم تصدره وزارة التضامن، وإنما أصدرته النيابة العامة، ومن ثم فإنه لا يعد قرارًا إداريًا مما يجوز للمحكمة الفصل في مدى مشروعيته، وإنما قرار قضائي لا تختص المحكمة برقابته أو الفصل في مدى اتفاقه مع أحكام الدستور والقانون. ليظل إيداع الطفل مستمر بالدار، وتستمر الأسرة في محاولات جديدة مع القضاء.
على الجانب الآخر، لم تحظ قضية «ميخائيل» بالتغطية والدعم الإعلامي الكافي، فعدد المواقع التي تناولت القضية لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، كما أن الأسرة لم تظهر في العديد من اللقاءات للحديث. ربما لا تملك الأسرة إمكانية الوصول لتلك المنصات مع تفضيلها الابتعاد عن الأضواء والمضي في المسار القانوني، و/أو ربما لا ترغب المواقع والصحف التابعة لسيطرة الدولة على المحتوى الخاص بها، التطرق للقضية، في مقابل تفاعل عدد من الناشطين بالخارج المهتمين بقضايا المواطنة والتدوين عنها. كان شنودة أوفر حظا من ميخائيل، إذ أن قضيته نالت الكثير من التغطية الإعلامية والحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وربما كان هذا السبب في صدور قرار النيابة بعد استطلاع رأي المفتي
لكن القضية ـ في الحقيقة وفي جميع الأحوال ـ لم تنته بعد، فبالطبع لن يعود الطفل كما كان من قبل، بعد فترة طويلة تصل لسنوات، حرم فيها من الرعاية الأسرية والإحساس بالأمان، وهو ما سيحدث مع ميخائيل أيضا .. هذا إن حالفه الحظ وصدر قرار مماثل بقضيته، فلن يعود كما عاد من قبل، ليظل السؤال المستمر، والذي نعرف إجابته مسبقا، ماذا استفادت الدولة؟