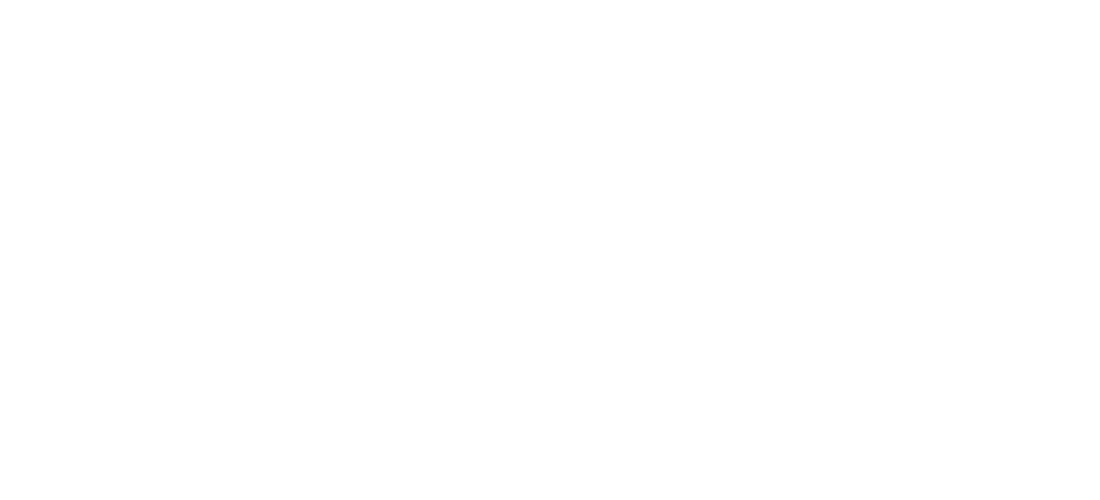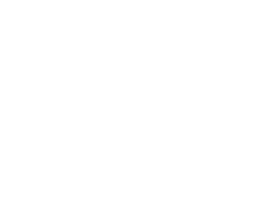د. خالد منتصر ـ الأهرام ـ
معركة اختيار مرشد الإخوان ما بين جبهتي إسطنبول ولندن انتهت بجلوس الطبيب الجراح مصطفى فهمي طلبه على مقعد المرشد، وبغض النظر عن كونه إنجليزياً يدير الإمبراطورية المالية الإخوانية هو وشقيقه علي، إلا أن مهنة الطبيب التي باتت قاسماً مشتركاً أعظم بين كل اتجاهات الإسلام السياسي، أصبحت تثير التساؤل، لماذا صار الأطباء هم الصيد السهل للإخوان؟ لماذا هم أكثر الناس شعبية وترشحاً للقيادة وحصولاً على الجماهيرية؟ لماذا هم أكثر كتلة انسجاما وتشدداً وتأثيراً؟ ولماذا أصبحت كليات الطب هي المشتل وخط الإنتاج الرئيسي لجماعات التطرف؟
لا بد أن نجيب عن هذا السؤال ولا نخجل من طرحه. وبصفتي أنتمي إلى تلك المهنة المقدسة والعظيمة، أعرف طبعاً أن هناك أطباء في منتهى الاستنارة والتفتح على كل الثقافات، لكن هذا لا ينفي صحة تلك الملاحظة التي طرحتها أو ذلك الاستنتاج الذي توصلت إليه. أنظر إلى معظم من تمتعوا بكاريزما القيادة وقوة التأثير داخل الجماعة ستجد معظمهم من الأطباء. حتى الاتجاه السلفي، بنظرة سريعة على الأعضاء المهيمنين على الجماعة السلفية بالإسكندرية كمثال ستجد أكثر من ٩٠٪ منهم أطباء.
هناك عدة عوامل ساعدت على وجود الأطباء بهذا الحجم والتكتل داخل جماعة الإخوان والسلفيين وتشكيل الإسلام السياسي ككل، وليست مصادفة أن يكون المطلوب رقم واحد الآن طبيب اسمه أيمن الظواهري، وأيضاً أن يكون فيلسوف ومنظر التكفير والجهاد في صورته القاعدية والداعشية الجديدة طبيباً اسمه سيد إمام أو الدكتور فضل، وهو أخطر من كتب وأثر وأصل هذا النوع من الفكر الإرهابي المتطرف. والظواهري وإمام من خريجي طب القاهرة ومن دفعتين متقاربتين، وبالصدفة الاثنان تخصصا في الجراحة، وكان كل منهما من الأوائل وهذا يشير إلى أنه لا علاقة بين الشطارة في مذاكرة الطب والمهارة في التحليل المنطقي العلمي.
العامل الأول هو تركيز الإخوان أنفسهم على استقطاب أبناء تلك المهنة لأنها تتعلق بصحة الناس وفيها تفاعل يومي معهم يسمح بالتأثير والتغلغل والهيمنة، ومع انتشار المستوصفات الخيرية والمستشفيات الإسلامية أصبح الطبيب الإخواني كتلة إخوانية مشعة ومؤثرة في المجتمع المحيط به مما يجعله خير رسولا للجماعة. وهناك استغلال قدرة طالب الطب على الحفظ والتي تدرب عليها من خلال ضغط المذاكرة لمنهج صفحاته بالآلاف المجبر على تخزينها في هارد ديسك دماغه في أيام قبل الامتحان، تجعله ماهراً فيما تريده الجماعة من إنسان ليس فقيهاً بالأساس، ولم يتعلم تعليماً دينياً منذ طفولته، وعندما يطلب منه حفظ كتب فقه وحديث وتفسير ورسائل حسن البنا، فإنه ينجز المهمة في وقت قليل وبدقة كبيرة.
العوامل الأخرى التي تجعل من الطبيب وقوداً للجماعات، ومجنداً سهلاً للإسلام السياسي المتطرف، هو طبيعة الدراسة نفسها. فهي للأسف صارت حفظاً في حفظ، وتلقيناً في تلقين. والمشكلة الأكبر هي في علاقة الأستاذ نصف الإله بالطالب المنسحق الذي ليس من حقه السؤال أو المراجعة لتشخيص أو خطة علاج البروفيسور الكبير. ويساعد على هذا طبيعة الامتحانات الشفوي التي تتفرد بها الكلية والتي تجعل من مزاج وذوق وانتماء وأفكار، وأحياناً ديانة، الأستاذ معياراً للتقييم. في أحيان كثيرة، كل هذا يجعل الطالب أو النائب الصغير يخرج من عباءة هيمنة الأستاذ الذي لا يجرؤ على سؤاله أو معارضته، إلى عباءة أمير الجماعة الذي لا يجرؤ على مناقشته أو الجدل معه، ليس أمامه إلا التنفيذ طبقاً لشعار لا تجادل يا أخي، وأنت بين يدي مرشدك كالميت بين يدي مغسله …الخ، إنه الانتقال السلس من الأساتذة الذين هم فقط أصحاب صحيح المعلوم، يقدمون إليهم المعلوم من الطب بالضرورة، إلى العلماء الذين لحومهم مسمومة، يقدمون إليهم المعلوم من الدين بالضرورة، وهؤلاء وأولئك الاعتراض على آرائهم ردة وكفر!
لكن ما هو الحل لكي نتدارك تلك المشكلة التي تتضخم يوماً بعد يوم ككرة الثلج؟
الحل هو في إدخال منهح العلوم الإنسانية وتذوق الفنون وتاريخ العلم في كليات الطب. حقنة فلسفة وعلم اجتماع وعلم نفس في الوريد، حتى يتعود الطالب على السؤال وفضيلة الشك والنقد، ويتأكد أن المنهج العلمي في التفكير هو طوق النجاة، وأن هناك ألوان طيف مختلفة، وأن الحقيقة نسبية، لا نريد أن تتحول كليات البالطو الأبيض لقبائل الجلباب الباكستاني، ونتمنى أن يجيد الطبيب تشريح الفكر إلى جانب تشريح المشرط، ولنثق أن الحكيم هو لفظ عبقري لوصف الطبيب، لابد من استعادته إلى قاموسنا وحياتنا، حتى نستعيد البهجة والحكمة والفرح والأمان والصحة.