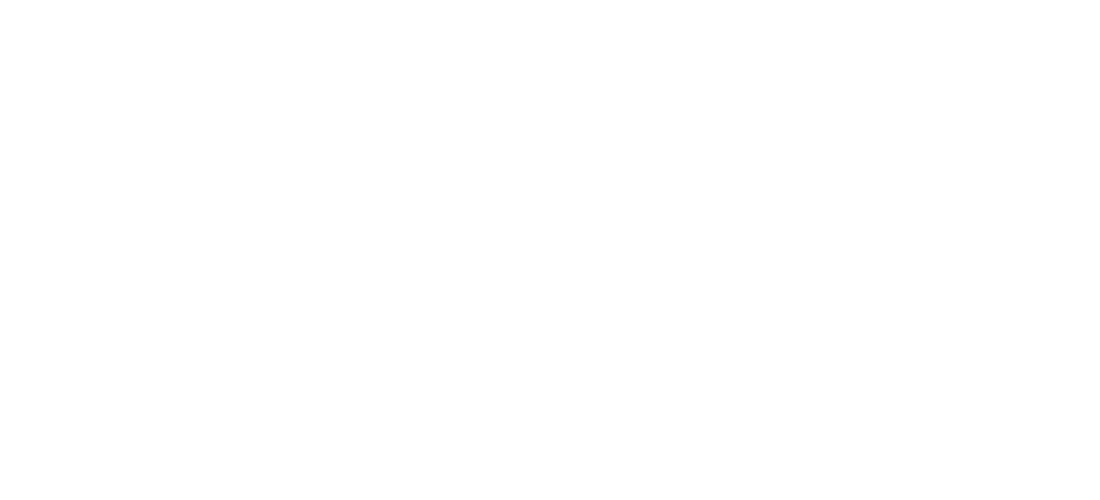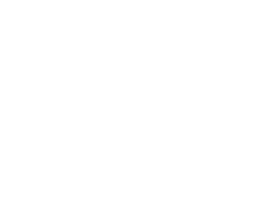شعبان يوسف ـ مبتدأ ـ
بعد مرور ثلاثين عاما من رحيل الكاتب والناقد والمفكر الدكتور لويس عوض، هل من الممكن أن نطرح سؤالا متأخرا جدا، ولكن إعادته مرة أخرى على الساحة ضرورة حتمية، وسوف يبدو غريبا للبعض، ومدهشا لبعض آخر، وهو : متى ننصف الدكتور لويس عوض؟، والمندهشون من السؤال سوف يبدون اندهاشهم اعتقادا أن الدكتور لويس عوض قد حصل على أكثر من حقه فى حياته وبعد رحيله، كما استفاض في ذلك الدكتور صبري حافظ في دراسته المطولة، والتي كتبها بعد رحيل عوض مباشرة، وسوف نناقش بعض تفاصيلها لاحقا، كما كتب أيضا فاروق عبدالقادر في نقده، وأوغل فى تجريحه، وكأن ثأرا بائتا كان بينهما، ولذا لم يترك عبد القادر مفردة هجاء واحدة إلا استعان بها لرجمه، ومن المدهش أنه استعان بالدكتور محمد عمارة في التحامل على لويس عوض، مما يجعلنا نقول بأن سلفية ثقافية وأدبية، توحدت مع السلفية الدينية السائدة، وذلك لهجو ورجم وإهانة وتحطيم ناقد كان من الممكن مناقشته الحجة بالحجة، والبرهان بالبرهان، كما تفترض قواعد الحوار الطبيعية والديمقراطية، وليس بالاتهام والتبليغ عنه لمن يهمهم الأمر.
الإجابة حول: هل لويس عوض يحتاج إلى إنصاف أم لا؟، وهل لحق بالرجل ظلم وتطاول واستبعاد فى حياته؟، أقول وأنا مطمئن لقولي: نعم يحتاج لإنصاف، بل يحتاج إلى اعتذار مطول وواضح وصريح، رغم المؤتمر الموسع الذى أقامه المجلس الأعلى للثقافة في سبتمبر2001 بمناسبة مرور عشر سنوات على رحيله، وبمشاركة أكثر من خمسين باحثا، ثم الاحتفال به مرة أخرى عام 2015 بمناسبة مئويته، وبمشاركة أكثر من ثلاثين باحثا.
إذن أين يكمن الظلم والاستبعاد والاضطهاد والإجحاف الذي نقصده، طالما أن الدولة الرسمية، وأحد أجهزتها الثقافية العملاقة أقامت له ـ بدلا من الاحتفال الواحد ـ احتفالين، وفى مناسبتين متتابعتين، وتم تكليف باحثين متخصصين لقراءة أعماله، وتقديم دراسات مستفيضة عن تلك الأعمال؟!
أقول مكررا بأن الهجوم الذى لاحق لويس عوض وطارده منذ أن برزت شخصيته الثقافية المختلفة والمتمردة على كثير من الثوابت الفكرية والأدبية والسياسية والثقافية، كان ضاريا للغاية ومدمرا في الوقت ذاته، ولم تحتمل الذائقة النقدية السائدة والثابتة جرأة هذا الباحث والشاعر فيما ذهب إليه، وربما لم يتعرض مثقف مصري طوال القرن العشرين كما تعرض لويس عوض من هجوم وتسفيه وتسخيف وتكفير، بل يتفوق على الهجوم الذى تعرض له أستاذه الدكتور طه حسين عندما أصدر كتابه الإشكالى “في الشعر الجاهلي” عام 1926، فطه حسين لاحقه الرجعيون والسلفيون المتشددون، ووجد طه حسين من يدافع عنه، ولكن لويس عوض هاجمه اليمين واليسار والقوميون والناصريون دفعة واحدة، ولأسباب عديدة، ولأن الرجل كان غزير الإنتاج، ومتنوع الطرح، فكان هناك من ينتظره على قارعة الطريق طوال الوقت للنيل منه، وهناك من كان يترصده دائما، ويقف له على الواحدة كما يقول القول السائر.
بلوتلاند وقصائد أخرى:
ولم تكن التهمة واحدة، بل كانت الاتهامات متنوعة، تبدأ بالانحياز إلى الثقافة المسيحية، والانتصار لها، وتغليبها على أي ثقافة، مرورا باتهامه بالجهل الكامل، وصولا بالاتهامات إلى مرتبة الجاسوس، استنادا إلى تلمذته على يد أستاذ إنجليزي، والذي أهداه ديوانه “بلوتلاند” الصادر عام 1947، هذا الأستاذ هو كريستوفر سكيف.
هذا الديوان هو بداية الحرب الشعواء التي تعرض لها عوض، ربما لم يلتفت أحد لهذا الديوان وقت صدوره، ولكن جاءت محاكمته متأخرة، وبأثر رجعى بعد ما كتب سلسلة أبحاثه التسعة “على هامش الغفران” عن أبى العلاء المعرى في جريدة الأهرام بين 16 أكتوبر و11 ديسمبر 1964، وتصدى لنقدها المحقق الأستاذ محمود محمد شاكر على صفحات مجلة “الرسالة”، ووجه لعوض سلسلة انتقادات حادة، وبعدها انفتحت بوابة كبرى للهجوم على عوض، وذلك على صفحات مجلتي “الرسالة والثقافة”، وهما من إصدارات وزارة الثقافة، وظل هذا الهجوم الضاري منذ خريف 1964، حنى صيف 1965 كما يذكر عوض نفسه في مقدمة كتابه “على هامش الغفران”، والذى صدر عن دار الهلال في أبريل عام 1966.
وفى الكتاب الذى أصدره الأستاذ محمود شاكر تحت عنوان “أباطيل وأسمار”، وهو رد مطول على كل ما كتبه لويس عوض حتى تلك السنة التي صدر فيها الكتاب عام 1966، بالإضافة إلى تناوله لأبحاث عوض عن أبى العلاء المعرى، وكتب شاكر في مقدمته: “..كان من سوالف الأقضية أن كتب الله علىّ يوما ما، أن أقرأ له شيئا ـ يقصد لويس عوض ـ سمّاه (بلوتلند، وقصائد أخرى)، وكتب تحته (من شعر الخاصة)، وأهداه إلى كريستوفر سكيف، وذلك في 1947 من الميلاد، ولما كنت أعلم خبء سكيف هذا، وأنه كان أستاذا في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وأنه كان جاسوسا محترفا في وزارة الاستعمار البريطانية، وأنه كان أيضا مبشرا ثقافيا شديد الصفاقة سيئ الأدب، وأنه كان ماكرا خبيثا خسيس الطباع..”. وهكذا يسترسل الأستاذ شاكر في وصف ذلك الأستاذ بسلسلة من الاتهامات البشعة، دون تقديم أي دليل على ذلك، حتى لو كانت دلائل شخصية، بعيدا عن أي أدلة وثائقية تثبت التهم التي شاعت وراجت عند كثيرين فيما بعد، مثلما جاءت في مقال الناقد الأدبي فاروق عبد القادر.
وعندما يكتب عبد القادر مقالا عنوانه “بلوتلاند .. تلك النكتة السخيفة القديمة”، يكرر تلك الاتهامات التي وردت في كتاب محمود شاكر بنوع من التشفي، كذلك دون أن يعطينا دليلا قاطعا على صحة الاتهامات، ولكنه يضيف لنا شهادة المؤلف المسرحي نعمان عاشور الذى كان فى ذلك الوقت طالبا بكلية الآداب، ويتحدث في شهادته عن عنصرية سكيف، ولكن هذه الشهادة كذلك لا تشفى أي غليل لنا حول حقيقة هذا الأستاذ البريطاني.
يطلق عبد القادر ماكينة الشتائم والتسخيف منذ العنوان الذى أطلق فيه على الديوان بأنه نكتة سخيفة، ويسخر فى شبه تشف من مقدمة عوض للديوان، والتي قال فيها عوض: “..مات الشعر العربي، مات عام 1932، مات بموت أحمد شوقي، مات ميتة الأبد، مات..”،
لم يناقش عبد القادر الديوان على محمل الجد، بل أطلق حفنة من السباب، ونفى عن أن يكون ذلك شعرا بشكل قاطع، يقول: “..وما نشره لويس عوض في بلوتلاند لا يمكن أن يكون شعرا على أي نحو فهمت الشعر: لغة ثقيلة سقيمة ركيكة رثة، فى ألفاظ حوشية غليظة، مثقلة بإحالات مضجرة إلى سطور من الشعر الأوروبي، في لغته أو غير لغته..”، ويسترسل فاروق في الحديث عن الديوان دون أن يورد لنا أي فقرة من الديوان، ذلك الديوان الذى كان مؤثرا على عدد من رواد الشعر في فصحاه وعاميته، وعلى القارئ أن يستحضر بعض السوناتات التي كتبها عوض، وكانت جديدة تماما ـ آنذاك ـ على الشعر العربي، ويقارنها بأثرها على شعر صلاح جاهين فيما بعد بعشر سنوات، يقول عوض:
جنيّة ليها ريش،
اتمددت عريانة
تتشمس ع الحشيش
وطبقت خجلانة
ستاير الرموش،
حر الجنوب لفحها
قالت تعال حوش
أو:
لغز الحياة دا سكره
الله نفخ من روحه
فى طينه لسه بكره.
الله محبة، قالوا:
إزاى باحب واكره؟
هو النبيت مش صافى،
ولا القزازه عكره.
أظن أن هذه الفقرات أو المقاطع المكتوبة باللغة الدارجة، كانت فاتحة لنمط جديد في الكتابة الشعرية، فى ظل وجود زجالين كبار من طراز بيرم التونسي وبديع خيرى وحسين شفيق المصري وأبو بثينة وغيرهم، وكانت أزجالهم تتردد بقوة فى عرض مصر وطولها، فضلا عن هيمنة هؤلاء الزجالين على سوق الأغنية، فتأتى تلك الكتابة لتتجرأ على الزجل السائد، وتكون رائدة للشعراء الذين أتوا فيما بعد مثل فؤاد حداد وصلاح جاهين.
المدهش أن ما كتبه عبد القادر وآخرون في «المسألة العوضية»، يتجاوز النقد الأدبي والفكري والثقافي والسياسي، ليصل بنا إلى حالة التفتيش فى النوايا. وبعيدا عن استناده إلى المحقق محمود شاكر، فهو يستدعى د محمد عمارة، الذى ينتقد لويس عوض، بل يهاجمه عندما كتب سلسلة مقالات عن جمال الدين الأفغاني تحت عنوان “الإيراني الغامض”، فيقول عبد القادر : “..ومرة ثانية يتصدى الدكتور محمد عمارة ـ محقق وناشر الأعمال الكاملة للأفغاني ـ لما كتبه لويس، وفنده فى ضوء معرفة واسعة بكتابات الرجل وأفكاره ودوره وعصره، وهو يرى أن لويس عوض قد رفض ما أجمع عليه أئمة العصر وأعلام علمائه الذين أرخّوا لجمال الدين..”.
هنا يكتفى عبد القادر بإدانة لويس عوض لمجرد أنه خالف الأئمة والعلماء، ولمجرد أن محمد عمارة أدانه دون أدلة، ولكنه يقول ـ مع عمارة ـ بأن لويس عوض لم يرفض إجماع العلماء والأئمة، إلا لكى يرضى الجواسيس الانجليز الذين كتبوا تقاريرهم عن الشيخ الأفغاني، ويمعن عبد القادر في تكرار تلك الترهات التي تلوك كلمات التجسس والخونة وما شابه ذلك، كما أنه يتهم عوضا فى الانحياز إلى ثقافته المسيحية.
حكاية المعلم يعقوب:
ويعرّج عبد القادر إلى حكاية “المعلم يعقوب” ويقول “..فهذا القبطي ـ هكذا ـ الذى انحاز للفرنسيين وعمل فى خدمتهم أثناء احتلالهم لبلاده، ورحل معهم حين رحلوا، ثم مات فى عرض البحر على ظهر السفينة الانجليزية التي تحمله فى زمرة الراحلين، أصبح عند لويس عوض بطلا قوميا، يقرن اسمه بإسمىّ محمد على وجمال عبد الناصر!”.
وكما استند عبد القادر إلى المحقق محمود شاكر في قضية ديوان بلوتلاند، وإلى د محمد عمارة فى بحث جمال الدين الأفغاني، يستند هنا إلى الدكتور أحمد حسين الصاوي فى دراسته “المعلم يعقوب بين الأسطورة والحقيقة”، ولا يختلف الصاوي عن د محمد عمارة في وصم لويس عوض بكافة الصفات المزرية، وفى استعراض عبد القادر لكتاب الصاوي في رده على لويس عوض، ويتبنى مقولاته بإفراط رغم سلفية الرجل، والذى وصفه “عوض” بأنه “أستاذ جامعي هدفه أن يكشف جانبا من الحقيقة، لا أن يلوى الحقائق ويسئ تفسيرها لخدمة أغراض خفية..”، ويتخلى عبد القادر هنا عن كونه الباحث إلى دور آخر لا يليق بباحث، عندما يفتش فى النوايا ويتحدث عن أغراض خفية، والمدهش أنه يكرر كلام د الصاوي، والذى يقول بأن لويس عوض رفع يعقوب إلى مصاف أبطال مصر وقادتها العظام، ويؤكد عبد القادر: “الغريب ـ حسب الصاوي ـ أنه تعمّد أن يغفل الإشارة إلى مذكرتي لاسكاريس المرفوعتين إلى بونابرت وتاليران.
ويكرر عبد القادر ذلك الزعم الذى يتهم “عوض” بتجاهل الوثيقتين، وعندما عدت إلى كتاب لويس عوض “المؤثرات الأجنبية في الأدب العربي الحديث”، والصادر عام 1963، سنجد أن لويس عوض لم يغفل مذكرتي لاسكاريس، وناقش الوثيقتين في صفحات 68و 69و70و71، ولاسكاريس هذا هو سكرتير المعلم يعقوب، والذى ينسب له محمد شفيق غربال مشروع أستاذه في استقلال مصر، والمدهش أن لويس عوض لم يورد الحديث عن الجنرال يعقوب إلا لكى يكشف عن تيار كان موجودا وفاعلا فى ذلك الوقت، وهو التيار الذى كان يكره المماليك ويقاتلهم، ومن ثم جاء يعقوب لكى يجد في الفرنسيين عونا لمقاومة المماليك.
أما عوض فقد وصف يعقوب وسكرتيره لاسكاريس بالشخصيات الخيالية ..”..لأن تاريخ حياة الجنرال يعقوب نفسه نفسه يدل على أنه كان إلى حد ما كصاحبه لاسكاريس شخصية دونكيشوتية، ولكن إلى حد ما فهو يحلق فى السحاب دون أن تنفصل قدماه عن الأرض”.
وأنا مندهش بالفعل من ادعّاء الباحث الدكتور “عفّ القلم” ـ حسب وصف عبد القادر له ـ من أن لويس عوض أغفل تماما مذكرتي لاسكاريس اللتين رفعهما إلى بونابرت وتاليران، والأكثر إدهاشا هو تكرار تلك الفرية من فاروق عبد القادر المعروف بدقته وبحثه عن المعلومة الصحيحة فى أبعد مرجع أو دليل.
مفاجأة مذهلة:
كان أول من لفتوا النظر إلى ما أثاره لويس عوض حول الجنرال يعقوب، هو الأستاذ محمد جلال كشك فى كتابه “الغزو الفكري”، والذى صدر تحت عنوان سلسلة “مفاهيم إسلامية”، وبعد أن هاجم “جلال كشك” مسرحية “الراهب” للويس عوض في فصل كامل، وسوّى مؤلفها على الجنبين ـ كما يقول الوصف الشائع، كتب فصلا آخر تحت عنوان “..والجنرال الخائن”، ويفتتح كشك الفصل بكلمة يرثى فيها الجنرال يعقوب صديقه الجنرال الفرنسي ديسيه، ويعقّب كشك قائلا :”..هذا الغزل .. بل الوله المخنث .. كتبه المعلم يعقوب أو الجنرال يعقوب يخاطب روح ديسيه القائد الفرنسي الذى فتح الصعيد وأغرقه في الدم”
ويستطرد: “..وهذا اليعقوب هو الذى يجعله الدكتور لويس عوض أول من نادى باستقلال مصر.. وذلك فى محاضرات الدكتور بمعهد الدراسات العربية التابع للجامعة العربية، والجنرال يعقوب هذا الذي كوّن فيلقا لضرب الشعب المصري ومعاونة الاحتلال الفرنسي ثم خرج هاربا مع جيش الاحتلال ومات على ظهر السفينة، فوضعوا جثته فى برميل من الروم لينفذوا آخر وصاياه الشاذة ويدفنوه مع ديسيه!”.
ولم يكتف كشك بهذا الفصل الذى هاجم فيه “عوض” ويعقوب معا، ووصفهما بأعتى الأوصاف التى رسخّت للخطاب الطائفي فى الثقافة المصرية، هذا الخطاب الذى استخدمه بضراوة فى مهاجمة مسرحية “الراهب” للويس عوض، وعقد مقارنة بين ما يريده الإسلام من خير، وما يريده القبط من تشتيت، لم يكتف كشك بذلك، ولكنه اكتشف أن القضية رابحة، فراح يوسّع الأمر، وكتب فصلا مطولا عن الجنرال يعقوب فى كتابه “ودخلت الخيل الأزهر”، والذى صدرت طبعته الأولى عام 1971، وكان كشك قد حسم أمره فى أن يكون بوقا لجماعات التطرف فى مصر والعالم العربي والعالم كله فيما بعد، ويكتب غزلا فى الوهابية بشكل واضح وسافر.
لكن أين المفاجأة التى أخفاها محمد جلال كشك طوال حياته، والتي لم يقترب منها إلا بحذر شديد، المفاجأة تكمن فى أنه كان أحد الأقطاب الذين دافعوا عن الحملة الفرنسية والجنرال يعقوب قبل أن تصيبه لعنة أموال المتطرفين، ومدح فى الجنرال يعقوب مديحا غير عفيف، وذلك عندما كان جلال كشك منتميا إلى الحزب الشيوعي ـ الراية ـ فى محافظة المنيا فى ذلك الوقت، ففي كتابه الأول “مصريون .. لا طوائف”، والذي صدرت طبعته الأولى عام 1951 عن دار النيل للطباعة، تلك الدار التي أصدرت كتاب “من هنا نبدأ” للشيخ خالد محمد خالد، ذلك الكتاب التنويري والطليعي، والذى أثار زوبعة الرجعيين بشدة آنذاك، ولذلك قد أهدى كشك كتابه هذا “إلى رجل الدين الحر.. خالد محمد خالد”، ولا أستبعد أن ذلك الإهداء جاء كنوع من ركوب الموجة العالية.
فى هذا الكتاب ـ مصريون.. لا طوائف ـ، والذى يستعرض فيه جلال كشك تاريخ القومية المصرية، يقول بالنص : “..ونحن نجد أول صدى هذه التيارات فى مشروع المعلم يعقوب لتحرير مصر من الحكم العثماني، فيعقوب من الأقباط الذين لازموا الفرنسيين منذ بدأت حملتهم فتمثل آراءهم السياسية، وكانت إلى ذلك الوقت مشبعة بروح الثورة الفرنسية، وما كاد يتبين اضطرارهم إلى ترك البلاد حتى عزم من ناحيته على الرحيل إلى أوروبا والسعي لتحقيق الاستقلال المصري بتخويف انجلترا مما لا بد أن يبعثه انهيار السلطة العثمانية من التنافس بين الدول مما يعرّض مواصلاتها مع الهند للأخطار ، واستمالة الرأي العالمي بما لمصر القديمة من أياد على الحضارة الانسانية..”، ويستطرد جلال كشك فى مديح المعلم يعقوب، ويعتبره أبا للقومية المصرية، ويستند فى ما كتبه إلى أحد المفكرين المصريين الكبار وهو “صبحى وحيدة” في كتابه “في أصول المسألة المصرية”، ويصل بنا كشك إلى أن يقول :”..ولكن دعوة المعلم يعقوب لم تنجح، فلم تكن مصر مهيأة لهذه الدعوة ، ولم تكن بالبلاد طبقة أو قوة اجتماعية قادرة على احتضان هذه الدعوة، لذا خبت حركة المعلم يعقوب بموته وخفتت نغمة القومية المصرية أو بالأحرى ضاعت هذه الصيحة الأولى فى وسط الصمم الإقطاعي الذى كانت تنوء البلاد تحته….”، ويستطرد: “..وهكذا نودع أول مصري أحس بمصريته وأول مصري ارتسمت فى ذهنه صورة لاستقلالنا عن الدولة العلية” !!!!!
يحق لى ولنا جميعا أن نضع مائة علامة تعجب بعد هذه الكلمات الحارة والساخنة والعاطفية التي أوردها محمد جلال كشك، بل كذلك الكلام الذى كتبه فى هذا الكتاب الذى لم يعد نشره حول الحملة الفرنسية التي لم تضئ شمسُ مصر إلا بدخولها، علامات التعجب لا تخص تلك الكلمات، بل تخص الانقلاب التدريجي عليها، الانقلاب لدرجة مائة وثمانين مرة، وقيادة الفيلق الذى جرّد لويس عوض من وطنيته، وشن الهجوم الكاسح على كافة كتاباته الأدبية والفكرية، واعتباره أحد الصليبيين الجدد فى مصر، كما اعتبره بأنه ضد القومية العربية والدين الإسلامي بشكل واضح.
تجريده من العروبة:
لم تكن تلك الاتهامات وحيدة، أو حبيسة زمن معين، فى حقبة ما، بل ظل لويس عوض هدفا ومرمى للنيران طوال حياته، وكأننا نعاقبه على اجتهاداته الفكرية الجديدة، ومهما جاء فيها من اختلاف وشطط ، ليس من الطبيعي أن يتعامل معه الكتّاب بهذه الكيفية، ووصمه طوال الوقت بأنه ضد القومية العربية، وأحد دعاة المشروع الغربي فى كل ما كتب، وها هو الناقد الدكتور صبري حافظ يشجب كل ما أتى به لويس عوض فى أعقاب رحيله، ويستكثر عليه عبارات الرثاء التي كتبها باحثون ومبدعون وكتّاب بعد رحيله، تلك المراثي التى “نصبت على مد صفحات الجرائد المصرية والعربية سرادقات من ورق امتلأت بكلمات التعازي التى لا تكتفى باتباع الحكمة الذهبية الداعية إلى ذكر محاسن الموتى وتعديد مناقبهم، وإنما تبالغ فى ذكر تلك المحاسن إلى حد الاختراع..”.
هكذا كانت مقدمة مقال د صبرى حافظ فى كتابه “سرادقات من ورق”، الذى صدر عام 1991 عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذى راح يدكّ فيه كل ما بناه وأسّسه له لويس عوض على مدى حياته كلها، بل إنه يستكثر عليه تلك الزيارات التي كان يقوم بها لويس عوض إلى بلاد الغرب وأميركا، واكتشف د صبري أن لويس عوض لم يكن ينقل حقيقة الأدب والثقافة والفن فى تلك البلاد، بل كان ينقل وجهة نظره فقط، تلك النظرة المغرضة والتي لا تعكس الحقيقة بأى وجه من الوجوه، والمدهش أن د صبرى راح يصف ويزيد فى الوصف دون التعرض بالرصد والتحليل وإرسال الأدلة على صحة ما يقول، فضلا عن نفيه لثقافة لويس العربية، وعدم معرفته بها بشكل قاطع وحاسم ولا يقبل المناقشة، هذا لأنه ـ أى لويس عوض ـ منحاز بشكل متعصب ومع سبق الإصرار والترصد إلى الثقافة الغربية والمشروع الغربي الاستعماري بشكل مطلق، وتفضيلها على كل ما هو عروبي، وهذا ما تم إشاعته، بل وترسيخه وتكريسه عبر كتابات متنوعة لكتّاب ونقاد وباحثين كبار منهم الناقد الكبير رجاء النقاش، الذى كتب كتابا كاملا عنوانه “الانعزاليون” وشن هجوما ضاريا على لويس عوض، وأفكاره، وتاريخه، مما اضطر لويس عوض أن يكتب فى مقال له تحت عنوان “معاتبات قومية” نشره فى جريدة الأهرام عام 1978يقول: “.. أقول إن التفتيش فى ضمائر الناس عن دوافع خفية تدفعهم إلى اعتناق المبادئ والتعبير عنها بدلا من التركيز على الحوار العلمي الموضوعي يضعف الحجة ولا يقويها، وهو خليق بمحاكم التفتيش التى انطوت فيما انطوى تاريخ الانسانية الحزين.. ولم تبق منها إلا آثار من الإرهاب الستاليني والهتلري والمكارثي”.
هذه الكلمات الحزينة التي أرسلها لويس عوض، تعنى بقوة أن تعسفا واسعا، وضربات قاسية، تشمل كل ألوان الطيف السياسي والفكري والعقائدي قد نالت من الرجل، وإذا كانت هذه المشاحنات التي حجبت التناول العقلاني والتعامل الصحي مع مشروع الرجل المتنوع شبه طبيعية فى ظل صراعات كانت قائمة لأسباب كثيرة، فهل نستطيع بعد انصراف كل المتحاربين عن أرض المعركة (أقصد عن الدنيا كلها!) أن نقرأ مشروع الرجل بحياد وتجرد عن كافة العصبيات التي أصابت بلادنا منذ قرن ونيف، كما يحق لنا أن نطالب بنشر آثار الرجل بشكل منتظم، وذلك أسوة بمفكرين وكتاب حدث معهم ذلك الأمر فى الآونة الأخيرة مثل محمود أمين العالم ود على الراعي، حتى تستطيع الأجيال الحديثة أن تتعرف على واحد من القامات الفكرية والثقافية الكبرى، تلك القامات التى أضافت أرصدة ثقافية وفكرية لا تنمحي بأي شكل من الأشكال، وعلى رأسهم الناقد والمفكر الدكتور لويس عوض، الذى ظل يتعرض لرياح سامة ولافحة طيلة نصف قرن كامل، وها نحن فى ذكرى رحيله الثلاثين نأمل فى إنصافه بالشكل الذى يليق به وبنا وبالمرحلة التاريخية التى نمر بها، وكذلك بما قدمه من تراث فكرى وسياسي وثقافي وإبداعي متنوع.