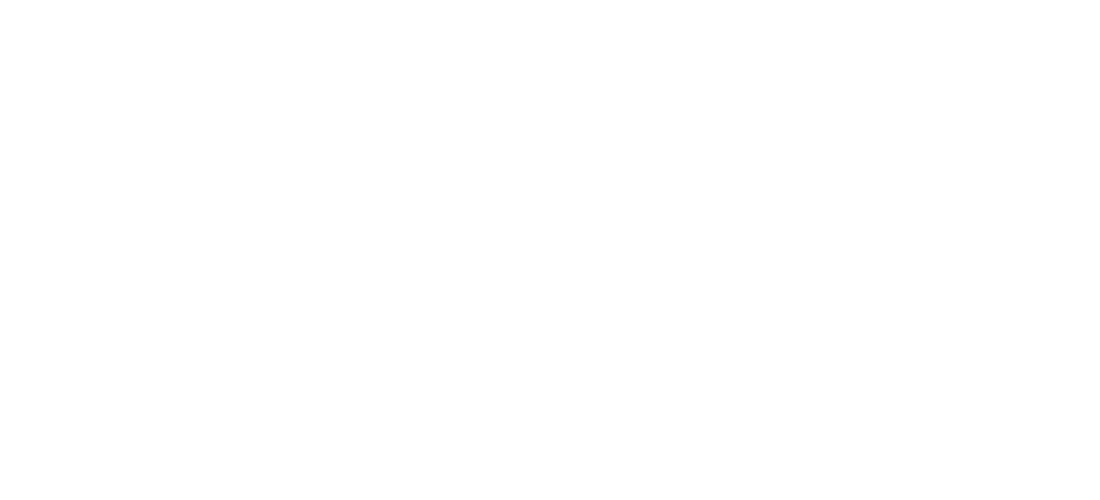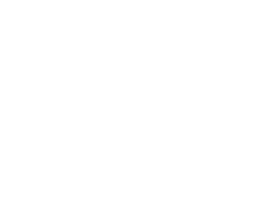في اللحظة التي يضع فيها الدستور يده على قلب الوطن ليقسم بالمساواة، يتسلّل إليه تناقض يشبه الشق فى المرايا: يعلن أن حرية العقيدة مطلقة، ثم يقيد ممارستها في الجملة التالية بعبارة للأديان السماوية. هنا يتوقف العقل أمام مفارقة فادحة: كيف تكون الحرية مطلقة ومشروطة في آنٍ واحد؟ وكيف يُختزل حق الإنسان في الإيمان أو اللاإيمان في قائمة معتمدة من الدولة؟ أولًا، النص يتناقض مع ذاته، فالمادة (64) من الدستور تنص على أن حرية العقيدة مطلقة، لكنها تضمن فقط حرية إقامة الشعائر للأديان السماوية. هذا النص في ذاته ينقض ذاته. فالحرية إن كانت مطلقة، فلا مجال لتصنيفها أو تقييدها بمعتقد دون آخر.
كما أن حصر ممارسة الشعائر في الديانات السماوية لا يمثل حماية للتعدد الديني، بل تجريمًا لما سواه. فهو يضع الدولة في موضع الوصي على الضمائر، ويجعلها تتصرف كما لو أن الاعتقاد قرار إدارى يخضع لترخيص رسمي، لا انبثاق ذاتي من الوعي الإنساني الحر.
وثانيًا، فإن مفهوم المواطنة في مأزق. المواطنة لا تُمنح ولا تُسحب، بل تُفترض بحكم الانتماء الإنساني للوطن. لكن عندما يميّز الدستور بين المواطنين فى حرية الاعتقاد، يصبح الانتماء نفسه مشروطًا بالعقيدة، لا بالولاء للوطن.
بهذا المعنى، يتحوّل الدين من تجربة روحية إلى بطاقة عبور مدنية، ومن علاقة بين الإنسان وخالقه إلى علاقة بين المواطن والموظف المختص في مصلحة الأحوال المدنية. ولعلّ المفارقة الأكبر أن نفس الدستور يجرّم التمييز بسبب الدين (المادة 53)، لكنه يشرّعه ضمنيًا في نص آخر. وهذه هي أزمة الضمير الدستوري في مصر الحديثة.
وثالثًا، فإن الفلسفة قد غابت. فحرية العقيدة في جوهرها، ليست مسألة قانونية، بل قضية وعى فلسفي. إن حرية الإنسان في أن يؤمن أو لا يؤمن، وأن يختار لنفسه معنى الوجود، هي ما يجعله إنسانًا. حين تتدخّل الدولة في هذا الفضاء الداخلي، فهي لا تنتهك القانون فقط، بل تتعدى على منطقة الوعي المقدسة. والمجتمع الذي يحدد للإنسان ماذا يؤمن، هو نفسه المجتمع الذي سيحدد له لاحقًا كيف يفكر، وكيف يحب.
ورابعًا، فإن المواطنة قبل العقيدة. أعظم الدساتير ليست تلك التي تحدد للناس أديانهم، بل تلك التي تضمن لهم حق الاختلاف في الإيمان دون خوف. في الدولة المدنية الحقيقية، الدين لله والوطن للجميع. أما حين يُصبح الدين شرطًا للمواطنة الكاملة، فإننا أمام نظام يختزل الإنسان في معتقده، ويقيس انتماءه بمقياس الإيمان الرسمي لا المشاركة الوطنية. هذا هو المنحدر الذي يبدأ باسم حماية العقيدة وينتهي باسم إقصاء البشر.
وخامسًا، فثمة حاجة لضمير دستوري جديد: نحن لا نحتاج إلى نصوص جديدة بقدر ما نحتاج إلى ضمير يقرأ النصوص بصدق. حرية العقيدة لا تكتمل إلا حين تُحترم في أضعف صورها: حين نكفلها لمن نختلف معهم، لا لمن يشبهوننا. الدستور بحاجة إلى مراجعة فلسفية لا لغوية، تضع الإنسان في مركز النص، لا المؤسسة الدينية، وتجعل المواطنة أسبق من الهوية العقائدية. فإن لم نفعل، سنظل نعيش فى تعارض دستوري وقانوني، يقدّس المبدأ وينقضه في السطر نفسه، ويظل الوطن حائرًا بين نصوصه، والمواطن مهددًا فى صميم إنسانيته.
فيا من تكتبون الدساتير بأقلامٍ تنبض باسم الوطن، تذكّروا أن حرية العقيدة ليست مِنّة من الدولة تُمنح أو تُسحب، بل هي أصل الكرامة الإنسانية التي تسبق القوانين وتعلوها. وأن الله، الذي خلق العقل، لم يفرض الإيمان قسرًا، فكيف يفعل الإنسان ذلك باسم الدستور؟
بالمناسبة، لمن بدأ في تصنيفي وتكفيري لمجرد تأكيدي حرية العقيدة بعد قراءةً الجزء الأول من المقال، فأنا مسلم بعقلي الذى جعلني احترم كل الديانات والمعتقدات ولا اقصرها على دين بعينه.
(…)
جزء من احترامي لأكثر من نصف البشرية الذين يعيشون على كوكب الأرض، الذين لا يؤمنون بالإسلام والمسيحية واليهودية يقودني الي الاعتراف بالقيم الإنسانية السوية التي سبقت الأديان مهما يكن مصدرها.
(…)
مجرد الاختلاف في تعريف كلمة، دون معرفة أصلها، أو الانقياد لمفهوم أيديولوجي أو ديني قد يؤدى الى كوارث. لابد من أن يتسع الصدر والعقل للفهم أولاً، والبحث وراء معاني وتعريفات الألفاظ ثانياً، قبل الوصول أساساً الى أن هناك اختلافًا من عدمه.
(..)
_____________