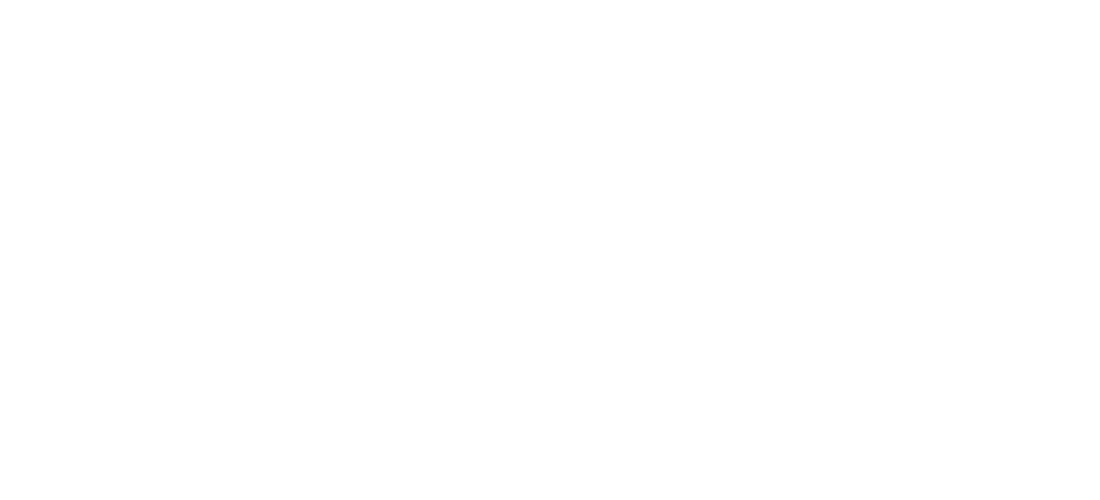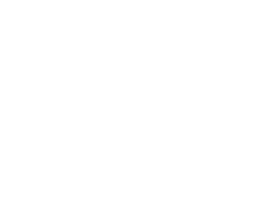سعيد فايز ـ
في مصر، لا تُنتهك حرية العقيدة لأنها غائبة عن الدستور، بل لأنها حاضرة فيه بقوة… وغائبة عن إرادة التطبيق.
فالدولة التي تنص في دستورها على أن «حرية الاعتقاد مطلقة»، هي ذاتها التي تتعامل مع التحول الديني من الإسلام إلى المسيحية باعتباره خطرًا يجب احتواؤه، ليس حقًا يجب حمايته.
التحول الديني ليس جريمة، ولم يكن يومًا كذلك في أي نص من نصوص القانون المصري. لا في قانون العقوبات، ولا في القوانين المكملة، ولا حتى في لوائح الأحوال المدنية. ومع ذلك، يُعاقَب المتنصّر عمليًا دون حكم، ودون محاكمة، ودون نص. عقوبته الوحيدة أنه قرر أن يكون صادقًا مع نفسه.
المفارقة الصادمة أن الدولة لا تقول صراحة: «التحول الديني ممنوع»، لكنها تتصرف على هذا الأساس. فتُغلق المسارات القانونية، وتُفتح المسارات الأمنية. يُستدعى المواطن لا بصفته صاحب حق، بل بصفته صاحب مشكلة. يُسأل عن دوافعه، ونواياه، وخلفياته، وكأن الإيمان جريمة تحتاج لتبرير.
المادة (64) من الدستور المصري واضحة لا تحتمل تأويلًا: حرية الاعتقاد مطلقة.
والمطلق في القانون لا يُقيّد بتعليمات، ولا يُدار بمنطق «المصلحة»، ولا يُعلّق على رضا الأجهزة. لكن الواقع يقول إن هذه الحرية «مطلقة» فقط في اتجاه واحد، أما الاتجاه الآخر فله حسابات مختلفة.
هنا لا نتحدث عن دين، بل عن دولة قانون.
الدولة التي تسمح لمواطن بتغيير معتقده شفهيًا، لكنها تمنعه من إثبات ذلك في أوراقه، هي دولة تطلب من مواطنيها أن يكذبوا كي يعيشوا. والدولة التي تُدخل الضمير الإنساني في دائرة الاشتباه الأمني، تفقد حيادها قبل أن تفقد احترامها.
الخطر الحقيقي ليس في التحول الديني، بل في تحويل الحقوق إلى ملفات، والمواطنين إلى قضايا، والدستور إلى لافتة. فحين يصبح الإيمان شأنًا أمنيًا، تتحول الدولة من حارس للحرية إلى وصي على الضمير.
والسؤال الذي لا يمكن الهروب منه:
إذا كان التحول الديني حقًا دستوريًا، فلماذا يُدار كجريمة؟
ومن الذي يخالف الدستور فعلًا: المواطن الذي غيّر معتقده، أم الدولة التي ترفض الاعتراف به؟
بطاقة الرقم القومي… سلاح الدولة ضد الضمير: حين تتحول الأوراق الرسمية إلى أداة قهر
في الدولة الحديثة، تُفترض الأوراق الرسمية وسيلة تنظيم، لا أداة إذلال.
لكن في مصر، تتحول بطاقة الرقم القومي – في حالة المتنصّر – من وثيقة تعريف إلى قيد دائم، ومن ورقة محايدة إلى أداة قهر صامتة تُجبر الإنسان على إنكار نفسه كل يوم.
المتنصّر لا يطلب اعترافًا دينيًا، ولا يسعى لفرض معتقده على أحد. كل ما يطلبه أن تُطابق أوراقه الرسمية حقيقة اختياره. لكن الدولة، بدلًا من التعامل مع الأمر كإجراء إداري بسيط، تحوّله إلى معركة طويلة مع مصلحة الأحوال المدنية، تنتهي غالبًا بالرفض غير المُسبب، أو التسويف، أو الإحالة إلى مسار أمني لا علاقة له بالقانون.
الخطورة هنا أن الدولة لا تقول للمواطن: «غيّر دينك سرًا»، لكنها تقول له ضمنيًا: «عِش بهويتين». واحدة حقيقية داخل الجدران، وأخرى مزيفة أمام المؤسسات. بطاقة تُجبره على الكذب في الزواج، في العمل، في التعليم، وحتى بعد الموت. وهنا لا نتحدث عن خلاف إداري، بل عن انتهاك مباشر للكرامة الإنسانية.
بطاقة الرقم القومي ليست مجرد خانة ديانة. هي مفتاح الحياة القانونية كلها. حين ترفض الدولة تعديلها، فهي لا تعاقب فكرة، بل تعاقب إنسانًا:
تُقيّد حقه في الزواج وفق معتقده
تُربك وضع أولاده
تخلق مشكلات في الميراث والدفن
وتضعه دائمًا في موضع الشبهة
الأدهى أن هذا القهر يتم بلا نص. لا يوجد قانون يمنع تعديل الديانة من الإسلام إلى المسيحية، ولا حكم قضائي عام يحرّم ذلك. الموجود فقط هو خوف الدولة من الاعتراف، فتستعيض عنه بالإنكار الإداري، وكأن الصمت يُنهي المشكلة.
الدولة التي تُجبر مواطنيها على حمل أوراق لا تُعبّر عنهم، لا تحمي النظام العام، بل تُهدده. فالكذب المفروض أخطر من الحقيقة المعلنة، والهوية المزدوجة أخطر من الاختيار الواضح. الاستقرار لا يُصنع بالقهر، بل بالاعتراف.
والسؤال الذي يفرض نفسه:
هل بطاقة الرقم القومي وثيقة تعريف… أم أداة عقاب؟
وهل وظيفة الدولة أن تُثبت الواقع، أم أن تُعيد تشكيله بالقوة
لا يوجد نص… إذن لماذا العقاب؟ فراغ تشريعي أم تعمد سياسي؟
في دولة القانون، القاعدة بسيطة وواضحة: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
لكن في ملف التحول الديني من الإسلام إلى المسيحية، تُقلب القاعدة رأسًا على عقب. لا يوجد نص يجرّم، ولا مادة تعاقب، ومع ذلك يقع العقاب كاملًا، وكأن القانون يُدار بالانطباع لا بالمبادئ.
ابحث في قانون العقوبات المصري من أوله لآخره، لن تجد نصًا واحدًا يُجرّم تغيير الدين.
راجع قوانين الأحوال المدنية، لن تجد مادة تمنع صراحة تعديل خانة الديانة.
اطّلع على التشريعات المكملة، لن تعثر على حظر قانوني واضح.
ومع ذلك، يُقال للمواطن عمليًا: «هذا غير مسموح».
السؤال هنا ليس قانونيًا فقط، بل سياسي بامتياز:
كيف تُدار دولة بلا نص؟
وكيف يتحول الفراغ التشريعي من مساحة للحرية إلى أداة للعقاب؟
ما يحدث هو استخدام مقصود لمفاهيم مطاطة: «النظام العام»، «السلم المجتمعي»، «الفتنة الطائفية». وهي مفاهيم لا تُعرّف، ولا تُقنّن، لكنها تُستدعى كلما قرر مواطن أن يمارس حقًا لا يروق للسلطة. فيتحول غياب القانون إلى سلطة غير مرئية، أخطر من وجود نص قمعي صريح.
الأخطر من ذلك أن الدولة لا تُحاكم الفعل، بل النية. لا تُناقش الإجراء، بل القناعة. ولا تسأل: هل خالف القانون؟ بل تسأل: لماذا اختار هذا الطريق؟ وهنا نكون قد خرجنا من دولة القانون إلى دولة الاشتباه.
الدولة التي تعاقب دون نص، تفتح الباب لتعسف بلا حدود. واليوم يُعاقَب المتنصّر، وغدًا يُعاقَب كل من يخرج عن «النمط المقبول».
لو كانت الدولة ترى في التحول الديني خطرًا، فلتملك الشجاعة التشريعية وتقول ذلك صراحة في قانون واضح، يخضع للرقابة الدستورية.
أما إدارة الملف بالصمت، والتعليمات، والتقدير الأمني، فليس حُكمًا بالقانون، بل تحايل عليه.
الفراغ التشريعي لا يعني المنع، بل يعني الإباحة. وهذا مبدأ قانوني مستقر، لا يحتاج لاجتهاد. لكن حين تختار الدولة أن تتجاهله، فهي لا تُطبق القانون، بل تُعلّقه.
والسؤال الذي يظل معلقًا: هل غياب النص صدفة تشريعية؟ أم سياسة مقصودة لإبقاء الحق بلا حماية، والعقاب بلا مساءلة؟
المتنصّر… المواطن غير المرئي :حياة كاملة خارج الاعتراف القانوني
في مصر، قد تكون مواطنًا كامل الانتماء… ناقص الاعتراف.
تعيش داخل الدولة، وتحت قوانينها، وتدفع ثمن كل شيء، لكنك غير موجود رسميًا كما أنت. هذا هو حال المتنصّر: إنسان حيّ، حاضر، لكنه غير مرئي في عين القانون.
المشكلة لا تتوقف عند خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي.
الأزمة تبدأ من هنا، لكنها لا تنتهي أبدًا. فحين تُجبر على الاحتفاظ بدين لا تؤمن به في أوراقك، تتحول حياتك كلها إلى سلسلة من التناقضات القانونية: زواج غير معترف به، أبناء في منطقة رمادية، وميراث قد يُحسم ضد قناعتك، ودفن قد يتم على غير ما تعيش وتموت عليه.
المتنصّر في مصر لا يعيش أزمة إيمان، بل أزمة دولة. الدولة التي ترفض الاعتراف بحقيقته، تضعه خارج منظومة الحماية القانونية. فلا هو مشمول بحقوق كاملة، ولا هو متهم صريح يمكنه الدفاع عن نفسه. إنه موجود في الفراغ… والفراغ في القانون عقوبة خفية.
في العمل، في التعليم، في التعامل مع المؤسسات، تظل البطاقة حاضرة لتذكّرك أنك «شيء آخر» غير ما تعيشه. لا تُجبرك الدولة على تغيير معتقدك، لكنها تُجبرك على إخفائه. لا تمنعك من الإيمان، لكنها تمنعك من الوجود به.
الأثر النفسي والاجتماعي لهذا الوضع لا يُقاس بالأرقام. إنه خوف دائم، حذر مستمر، وحياة بلا استقرار. المتنصّر لا يسأل: «ما حقي؟» بل يسأل: «هل سيُكتشف أمري؟» وهنا تتحول الدولة – دون أن تعلن – إلى شريك في إنتاج القلق.
الأخطر أن هذا الإقصاء لا يضر الفرد وحده، بل المجتمع كله. المجتمع الذي يدفع أفراده للعيش بهويتين، يزرع بذور الانفصام. والسلطة التي تخلق مواطنين غير معترف بهم، تخلق تلقائيًا شعورًا بالاغتراب، لا بالانتماء.
الدولة القوية لا تصنع مواطنين غير مرئيين.
والقانون الذي لا يرى الإنسان كما هو، لا يحميه.
فالاعتراف ليس منحة، بل وظيفة أساسية لأي دولة تحترم نفسها.
والسؤال الذي يجب ألا يُنسى: كيف تطلب الدولة من مواطن أن يكون مخلصًا لها، وهي ترفض أن تعترف بوجوده الحقيقي؟
الكنيسة صامتة… والدولة مرتاحة: من يترك المتنصّر وحيدًا في المواجهة؟
في كل معركة غير متكافئة، أخطر ما يواجهه الإنسان ليس الخصم، بل العزلة. والمتنصّر في مصر لا يواجه الدولة وحدها، بل يواجهها وحيدًا. لا مظلة تحميه، ولا جهة تتبناه، ولا صوتً يتحدث باسمه بوضوح. الدولة مرتاحة، لأن الطرف الآخر صامت.
الكنيسة، بحكم طبيعتها الروحية، ليست جهة سياسية ولا خصمًا للدولة. هذا مفهوم. لكنها أيضًا ليست مجرد شاهد محايد على معاناة إنسانية وقانونية تمس أبناءها. الصمت الكامل هنا لا يُقرأ كحياد، بل يُفهم – في نظر المتضرر – كترك متعمد للفرد في مواجهة مصيره.
المتنصّر لا يطلب من الكنيسة معركة، ولا صدامًا مع الدولة. هو يطلب دعمًا إنسانيًا، موقفًا أخلاقيًا، أو حتى اعترافًا صريحًا بوجود أزمة. لكن حين يغيب هذا كله، تتحول القضية من حق عام إلى وجع خاص، ومن مشكلة قانونية إلى عبء شخصي لا يحتمله فرد وحده.
هذا الصمت يمنح الدولة راحة غير مستحقة. فغياب الصوت المقابل يجعل الملف يبدو وكأنه غير موجود. لا ضغط مجتمعي، لا نقاش عام، لا مساءلة. وهكذا تستمر السياسة نفسها: لا اعتراف، لا حل، لا حتى إنكار رسمي.
المفارقة أن الكنيسة، حين تصمت، لا تحمي نفسها كما يظن البعض، بل تُضعف موقف أبنائها. فالدولة لا ترى إلا من يتكلم، ولا تسمع إلا من يطرق الباب. أما من يتألم في صمت، فيُترك للزمن أو للانكسار.
لكن المسؤولية لا تقع على الكنيسة وحدها. الدولة أيضًا تستفيد من هذا الصمت، وتتعامل معه باعتباره قبولًا ضمنيًا بالوضع القائم. فحين لا يُطالب أحد بتغيير المسار، يصبح القهر هو «الطبيعي»، والاستثناء هو المطالبة بالحق.
القضية هنا ليست دينية، بل أخلاقية وقانونية. حين يُترك المتنصّر بلا سند، تُكسر فكرة المواطنة ذاتها. وحين تُدار الدولة شؤون الضمير بمنطق «الصمت أفضل»، نخسر جميعًا، حتى من يظنون أنفسهم في مأمن.
والسؤال الذي يجب أن يُطرح بصدق: هل الصمت حكمة؟ أم أن ثمنه يدفعه فرد أعزل لا صوت له؟
المتنصّرون والأزهر: حين يتحول الرفض الديني إلى مأزق قانوني
في كل نقاش حول التحول الديني في مصر، يبرز اسم الأزهر بوصفه المرجعية الإسلامية الأهم، وصوتًا دينيًا مؤثرًا في المجال العام. ومع هذا الحضور، يصبح من الضروري طرح السؤال بهدوء وصدق: ما موقع المتنصّرين من موقف مؤسسة الأزهر؟ وهل الرفض الديني للتحول يجب أن يمتد ليُقيّد حقًا قانونيًا؟
الأزهر، كمؤسسة دينية، يرفض التحول من الإسلام إلى أي دين آخر، ويعتبره خروجًا عقديًا لا يقبله من حيث المبدأ الديني. هذا موقف واضح ومعلن، ولا جدال في حق المؤسسة الدينية في تبني رؤيتها العقائدية والدفاع عنها. الإشكال لا يبدأ هنا، بل يبدأ حين يتحول هذا الرفض الديني إلى مرجعية غير معلنة لإدارة حق مدني.
المتنصّر في مصر لا يطلب من الأزهر اعترافًا بعقيدته، ولا فتوى تُقر خياره، ولا مباركة دينية. كل ما يطلبه هو أن تتعامل الدولة معه كمواطن، لا كمسألة فقهية. لكن الواقع يقول إن الموقف الرافض للتحول داخل الخطاب الديني الأزهري يلقي بظلاله الثقيلة على القرار الإداري والأمني، حتى وإن لم يُعلن ذلك صراحة.
وهنا يحدث الخلط الخطير بين المجالين: الدين يُصدر حكمًا عقديًا، والدولة تُفترض أن تُصدر قرارًا قانونيًا. لكن حين تختفي هذه الحدود، يُترك الفرد معلقًا بين رفض ديني لا يستطيع مجادلته، وحرمان قانوني لا يجد له سندًا تشريعيًا.
الأزهر، بحجمه وتأثيره، لا يمكن اعتباره مجرد طرف محايد في هذا الملف. صوته مسموع، ورأيه مؤثر، وصمته أو رفضه يُترجم عمليًا إلى واقع يعيشه المتنصّر كل يوم. وحين لا تُطرح أي مساحة للنقاش حول الحقوق المدنية للمتنصّرين، يصبح الرفض موقفًا مكتمل الأثر، حتى دون تدخل مباشر.
المشكلة ليست في أن الأزهر يرفض التحول، بل في أن هذا الرفض يُستخدم – أو يُفهم – كتبرير لحرمان مواطن من حقوقه الدستورية.
فالدولة ليست مطالبة بأن تُخالف عقيدة الأغلبية، لكنها مطالبة بأن تحمي حقوق الأفراد، حتى لو خالفت السائد. والدولة القوية لا تضع المؤسسات الدينية في مواجهة الحقوق، ولا تُحمّلها عبء القرار القانوني.
والأزهر نفسه، إن أراد الحفاظ على مكانته الروحية، يحتاج إلى التأكيد الدائم على الفصل بين الموقف العقدي والحق المدني، حتى لا يُفهم الرفض الديني كغطاء لتعطيل الدستور.
في النهاية، المتنصّر لا يقف في مواجهة الأزهر، ولا يسعى لصدام معه. بل هو يقف في مواجهة فراغ: فراغ تشريعي، وفراغ اعتراف، وفراغ حماية. وما لم يُملأ هذا الفراغ بالقانون الواضح، سيظل الرفض الديني – مهما كان مشروعًا في مجاله – سببًا غير مباشر في معاناة إنسانية لا يجب تجاهلها.
والسؤال الذي يظل مطروحًا بهدوء: هل يمكن للدولة أن تحمي حقًا دستوريًا، دون أن تطلب من مؤسسة دينية أن تغيّر قناعتها؟
حرية العقيدة لا تتجزأ: إما حق كامل… أو كذب دستوري
في مصر، لا تُناقَش حرية العقيدة بوصفها حقًا إنسانيًا عامًا، بل بوصفها مسارًا واحدًا مسموحًا به، ومسارات أخرى يُفضَّل تجاهلها.
فالتحول الديني مقبول، بل مرحّب به، حين يكون في اتجاه واحد. أما حين يختار الإنسان الاتجاه العكسي، يتحول الحق فجأة إلى مشكلة، والاختيار إلى تهديد.
لا يوجد في الدستور ما يقول إن حرية العقيدة «انتقائية». ولا يوجد نص يفرّق بين من يختار هذا الدين أو ذاك. فالحق، بطبيعته، لا يعرف الاتجاهات. إما أن يكون مكفولًا للجميع، أو لا يكون موجودًا أصلًا.
المفارقة المؤلمة أن الدولة لا تمنع التحول الديني صراحة، لكنها تمنعه عمليًا. لا تُصدر قرارًا، لكنها تُعطّل الإجراء. لا تُعلن الرفض، لكنها تُطيل الطريق حتى ينهك صاحبه.
وهكذا يتحول الحق من ممارسة طبيعية إلى اختبار صبر وقدرة على الاحتمال. حين يُعلن شخص تحوله إلى الإسلام، تُفتح له الأبواب. تُيسَّر الإجراءات، تُسهَّل الأوراق، ويُنظر إليه باعتباره قصة نجاح.
لكن حين يقرر آخر التحول من الإسلام إلى المسيحية، يُقابل بالشك، والتخويف، والتسويف، وكأن الاختيار ذاته خطأ يجب تصحيحه.
هذه الازدواجية لا تضر المتنصّرين وحدهم، بل تضر فكرة الدولة ذاتها. الدولة التي تطبق الحق في اتجاه، وتمنعه في اتجاه آخر، لا تحمي الاستقرار، بل تُقنّن التمييز. والتمييز، مهما بدا مريحًا في لحظته، لا يصنع مجتمعًا آمنًا.
حرية العقيدة ليست منحة تُعطى لمن «يحسن الاختيار» من وجهة نظر الأغلبية. بل هي حق لصيق بالإنسان، يُمارسه وحده، ويتحمل نتيجته وحده. وحين تتدخل الدولة لتوجيه الضمير، تفقد حيادها قبل أن تفقد شرعيتها.
المشكلة ليست في أن المجتمع يرفض المختلف، فالمجتمعات تخاف مما لا يشبهها. المشكلة حين تتبنى الدولة هذا الخوف، وتحوّله إلى سياسة صامتة. هنا لا يعود الحديث عن دين، بل عن مواطنة منقوصة.
حرية العقيدة لا تتجزأ. لا تُمنح بنصف حق، ولا تُدار بنصف اعتراف، ولا تُحترم في اتجاه واحد.
إما أن نقبل الإنسان كما هو، أو نعترف بصدق أننا نخاف من حريته.
_____________________________________________
(*) محامٍ بالنقض ـ باحث دكتوراه في القانون الجنائي