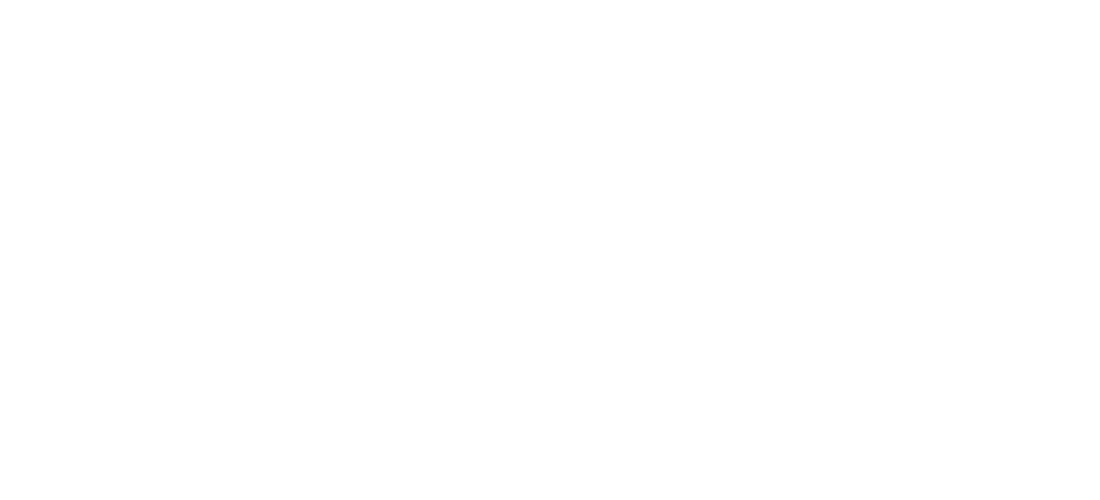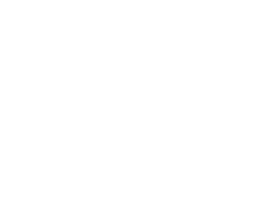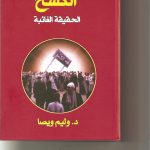د. شريف يونس ـ
اكتسب مسار “الصحوة” ككل، وحتى بعيدا عن منظماتها، طابعا عدوانيا شعبويا، محوره هو امتلاك أو اغتصاب المجال العام. كانت خطب المحلاوي في الإسكندرية وكشك في القاهرة وغيرهما (فضلا عن الشرائط المسجلة في غرف مغلقة) تنضح بالكراهية للفن والفكر والحرية، ولكل المخالفين والناقدين للتعصب. أصبح التعصب قيمة في ذاتها، وأصبح إعلان الكراهية معيار “قوة الإيمان”. فبقدر شمول الكراهية وعنفها، والرغبة في التمايز والانعزال الشعوري عن المجتمع، يصبح إسلام الفرد أكثر نقاءً، بمعيار تماهيه مع نموذج وضعه تنظيم من التنظيمات أو آخر، أو أحد الدعاة الأصوليين، لماهية الإسلام.
تحت سمع وبصر الدولة البوليسية، انتشر عنف مجتمعي إسلامي كالفطر. تبارت المساجد في الانتشار، خصوصا إلى جوار الكنائس. مثلا، كانت إقامة مسجد ضخم في العباسية (مسجد النور) “ملحمة” خاضها الإسلاميون وعبأوا الناس لها بجمع التبرعات بهدف “التفوق” على الكاتدرائية القبطية القريبة من العباسية في علو البناء والمآذن، وانتشر هذا السلوك في كثير من أنحاء البلاد. وتبارى الجميع في تركيب ميكروفونات أقوى وأكثر عددا في المساجد، حتى أصبح الأذان يصم الآذان، مع العناية بصفة خاصة بالأحياء التي تضم نسبة ملموسة من المسيحيين؛ إثباتا “لعزة” الإسلام، التي أصبحت تتمثل، في ظل “الصحوة”، في القدرة على “الاستعلاء بالحق” على الآخرين وإيذائهم. وانتقلت العدوى للميكروباصات والمحال التجارية، بل وجرت محاولات لفرضها في المركبات العامة الحكومية، وتبارى خطباء الجمعة في إطالة الخطبة بقدر الإمكان، وفي الصياح بأعلى صوت، وفي تحميل الخطب نفسها بأكبر قدر من الكراهية للنساء والمسيحيين والنظام والمثقفين، ولأي شيء يُبدي أية مقاومة للانجراف في شلال هذه الهستيريا الغاضبة. ولولا أن الحكومة قررت إغلاق المساجد بين الصلوات لأغراضها الخاصة (حتى تحد من تحولها لأوكار لجماعات إرهابية ومتطرفة)، لاستمر هذا الاستعراض المنفجر للكراهية معظم ساعات اليوم.
والواقع أن “الصحوة” رغم تمحورها حول هدفها السياسي الغامض المسمى الخلافة أو الدولة الإسلامية، فإنها كانت في أساسها ظاهرة ثقافية؛ فهدفها الذي تجند الناس وتطلب السلطة بناء عليه هو “تعبيد الناس لربهم”، وهو تصور يشمل محو أو تدمير جوانب بأكملها من وعي الناس ومشاعرهم ونمط حياتهم. وبصفة خاصة، كان مبدأ الصحوة، رغم أنه مبتدع بالفعل، معاديا بشكل صارخ لمفهوم الإبداع، سواء الفني أو الفكري، مطالبا بهيمنة شاملة على مشاعر الناس وعقولهم. وكان العنوان العريض لهذا المبدأ هو – مرة أخرى – ما أسماه سيد قطب “العزلة الشعورية”، أي أن يعزل أعضاء تنظيمات “الصحوة” ومن آمن بدعوتهم أنفسهم روحيا عن مجمل “الجو” الاجتماعي لأنه ملوث ومتعدد، وبالذات عن كل ما يرتبط بالإبداع أو الفكر الحر أو الترفيه، وعما له علاقة ما بالنساء بالنسبة لذكور الصحوة، أو بالرجال بالنسبة لنسائها. بهذا المنطق، أعلنوا كراهة أو تحريم التلفزيون والراديو (إلا ما كان دينيا صرفا، أو خاضعا لهيمنة رجال الصحوة)، والسينما والمسرح والمقاهي والمنتزهات كأماكن مكروهة، ومعظم أشكال الفنون. وأسهمت الأموال “الإسلامية” في محاولة تحقيق هذا الهدف، بتمويل تحجيب فنانات وجذب فنانين، وتحويلهم لممارسة دعاية إسلامية، وشراء المحال الشهيرة لإعادة تشغيلها “إسلاميا” أو تحويل نشاطها تماما.
كان التصور الذي ساد “الصحوة” بشأن كل ما يخالفها ثقافيا هو أنها أدوات “إفساد”، يجب إخضاعها تماما بحيث تبث رسالة “الصحوة” وحدها، وما يتفق معها، وما تجيزه دون غيره، أو تجنُّبها كليةً، وطوردت كل ظواهر الحياة الاجتماعية، من الكلمات (قل كذا ولا تقل كذا)، إلى الملابس إلى السلوك إلى الآداب الاجتماعية (لا تشكرني، الشكر للـه)، باعتبار تنميط المسلمين وفصلهم – بداية من اللغة والسلوك الاجتماعي – عن غيرهم، فضيلة، بل الفضيلة بألف لام التعريف. كان هذا التصحير الثقافي هو الجانب الوحيد الواضح في فكر “الصحوة”. وكان “الجهاد” المسلح وغير المسلح لإقامة الدولة المنشودة يهدف تحديدا إلى جعل هذه “الفضيلة” إجبارية على الجميع، بحيث يجري “تفصيل” البشر جميعا على مقاس متقارب ومتفق مع النموذج.
بالإضافة إلى الدعوة، كان المنشود من التحكم الشامل إعدام أو حبس أو عقاب كل من يجرؤ على نقد المثل الأعلى للصحوة وممارساتها. لكن حتى بغير الاستيلاء على سلطة الدولة، اتجهت فصائل من الصحوة إلى العنف الفكري والمادي. تعملَقت آلهة انتقام “الصحوة” صارخة مطالبة بإراقة دماء “الأضاحي” البشرية على مذبح مقدساتها. ومن قبيل ذلك قتل فرج فودة ومحاولة قتل نجيب محفوظ، وتكفير نصر حامد أبو زيد باستخدام “القانون”، إثباتا لحق إباحة دمه. مورِس هذا كله بحماس جارف واندفاع لتصحير كل المجالات الثقافية وصبَّها على مقاس الصحوة؛ فتصاعدت اتهامات التكفير، حتى أن بعض كُتَّاب “الصحوة” كفَّروا مُكفِّرين آخرين. ولم يقتصر التكفير على الأحياء، بل شمل الموتى، مثل طه حسين، في محاولة لتجريف البلاد بالكامل من أي تراث سوى مستحدثات الصحوة القطبية، وما أجازته وعدَّلته من التراث. وبطبيعة الحال لم يعد التراث الفرعوني العظيم سوى “فرعونية” بالمفهوم التوراتي، وأصبح وجوده في المناهج الدراسية يستوجب “اعتذارا” من واضعي المناهج عن “كُفر” حضارة عظيمة امتدت آلاف السنين.
أصبح العنف التكفيري شاملا، لا يُبقي ولا يذر”.
(من كتاب «البحث عن خلاص»، الفصل الثالث عشر)
عن طبيعة المجال العام الذي صنعته "الصحوة" الإسلامية في أربع عقود في البلاد:"اكتسب مسار "الصحوة" ككل، وحتى بعيدا عن…
Posted by صفحة الباحث والكاتب د.شريف يونس on Sunday, December 29, 2019